على مسؤوليتي
دولة ولي العهد و”حزب” العدل والإحسان 1/2
نشرت
منذ 10 أشهرفي
بواسطة
مراد بورجى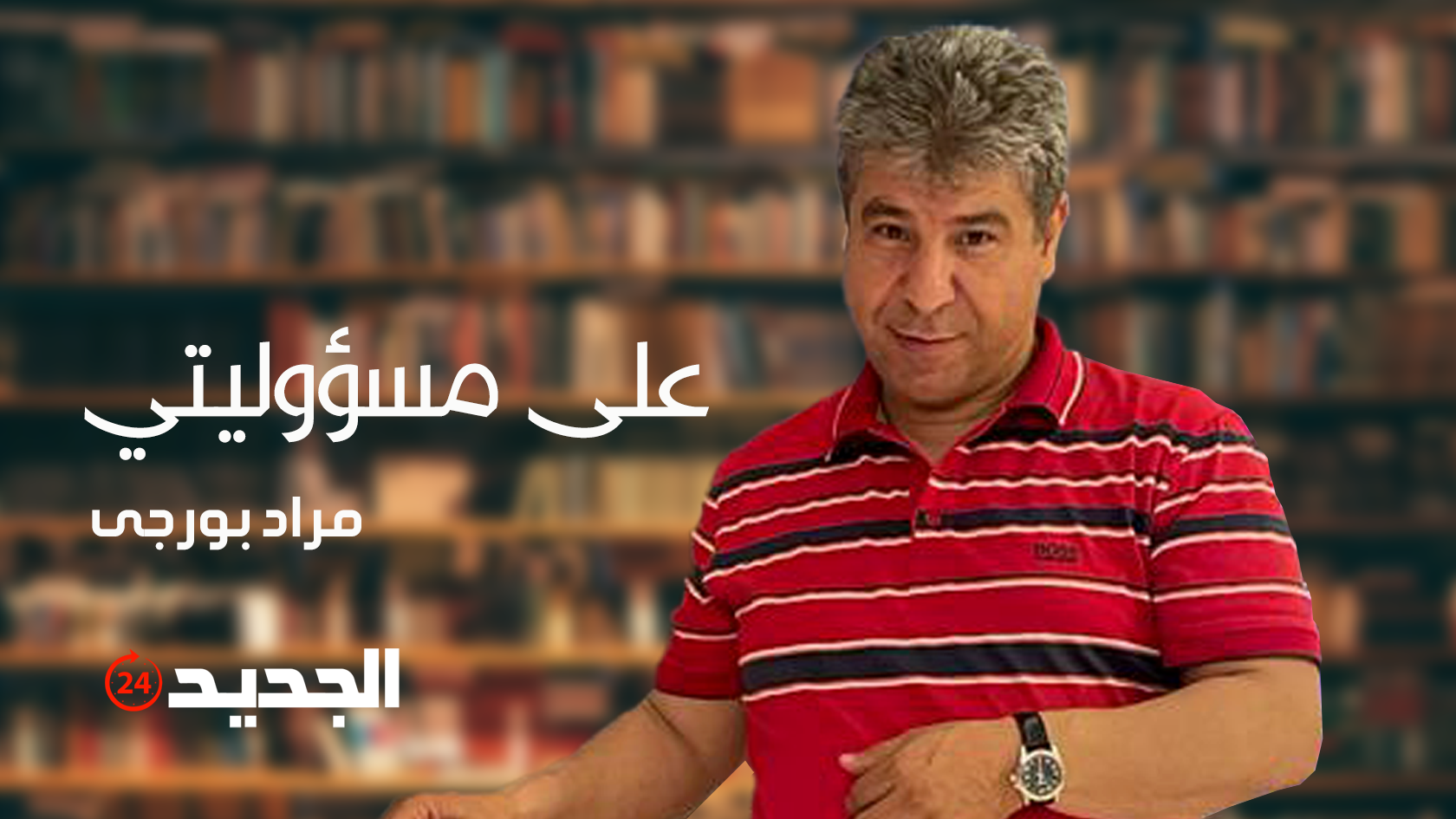
1/2- المجلس التأسيسي والملكية البرلمانية وإمارة المؤمنين والبيعة
* مراد بورجى
أثار مقالي عن “دولة ولي العهد وشباب جماعة العدل والإحسان ورهانات البناء والتحرير” الكثير من الجدل من العدليين ومن خارجهم.
جوهر المقال يطرح أفقا ممكنا لعلاقة مفترضة بين جماعة العدل والإحسان وبين النظام السياسي المغربي، من زاوية الانخراط الإيجابي في المشهد السياسي المغربي، أي المشاركة في مسارات بناء مغرب الغد، وهو ما أدخلته ضمن سلسلة من مقالاتي عن “دولة ولي العهد”، وارتأيت تخصيص حلقة ثانية وبعدها ستكون هناك حلقة ثالثة لمواصلة النقاش حول العدل والإحسان والنظام السياسي، من خلال قضايا الملكية والديمقراطية وإمارة المؤمنين والبيعة، على ضوء الخرجات الإعلامية لمصطفى الرميد، الوزير السابق والقيادي المستقيل من حزب العدالة والتنمية، الذي كانت له، مؤخرا، كلمة مثيرة انتشرت كالنار في هشيم الساحتين السياسية والإعلامية، عندما قال، بثبات ووثوقية، إن “المخزن العميق نعمة”!!.
لم أكن مبالغا عندما اعتبرت، في حينه، أن هذه الكلمة هي “رسالة” بعثها الرميد إلى من “يهمهم الأمر”، وهم “جماعة العدل والإحسان”، باعتباره مؤهّلا لـ”يتكلّف” بهذه المهمة، إذ هو وسيط مقبول ومناسب لأي حوار مفترض مرتقب، فهو يحوز “ثقة الدولة”، و”ثقة الجماعة”… وجدير بالذّكْر، هنا، من جهة، التذكير بالعلاقة الوثيقة بين الرميد والجماعة، التي سأعود إليها في فقرات لاحقة، ومن جهة ثانية، الإشارة إلى أن المُخاطب الموثوق لدى “المخزن” في مبادرة العفو الملكي على الصحافيين والمدوّنين والنشطاء المدنيين والعدليين كان هو الرميد، وزير العدل الأسبق وليس وزير العدل الحالي الذي أبعده المخزن عن ذلك.
عندما أكدت، في مقالي السابق، أن “رؤية” جماعة العدل والإحسان للوضع السياسي الراهن تُميّز بين العمل الدعوي والعمل السياسي، فقد كان القصد، أن “نظرة” الجماعة، من هذه الزاوية، لم تعد تحمل أي حدّ أو “فيتو” إزاء شكل النظام السياسي، رغم استمرار بعض “الزوايا الرمادية”، التي “تكلّف” الرميد بتشريحها ووضعها في سياقاتها لتذويب حواجزها، من خلال خرجاته الإعلامية، التي باتت تتعدّد وتتوالى في الفترة الأخيرة، منها مثلا أنه في بداية شهر يونيو الفارط، كانت له خرجة في فاس، خلال مشاركته في ندوة نظمتها هيئة المحامين بفاس والجمعية المغربية لحماية المال العام، حول “ربط المسؤولية بالمحاسبة وتجريم الإثراء غير المشروع”، وفي نهاية الشهر نفسه، كانت له خرجة أخرى قوية، من خلال الحوار المطوّل الذي أجراه معه موقع “صوت المغرب”، ضمن برنامج “ضفاف الفنجان”، وفي الخرجتين، كما هي عادته، أثار الرميد وراءه الكثير من الجدل.
لشخصية الرميد مواصفات كاريزمية، في عرض مواقفه، والدفاع عن طروحاته، وحشد المناصرين. بيد أن هذه الكاريزمية تحد من انطلاقتها “الحماسة الزائدة” في ممارسته للسياسة، “حماسة” يصفها هو بـ”الالتزام” و”المبدئية”، بينما ينعتها خصومه ومنافسوه بـ”المشاكسة” و”المشاغبة” و”الاندفاعية”، التي كانت تخلق له متاعب شتى مع شركاء حزبه السياسيين، من أحزاب وحكومة، بل كان يخوض، أحيانا، صراعات قوية حتى مع زملائه في قيادة العدالة والتنمية، وطالما فاجأهم بخرجات إعلامية قوية، يطلق فيها تصريحات “نارية”، وأحيانا كان يضطر إلى الدخول في عملية “اعتزال سياسي” معلنة، يقاطع خلالها اجتماعات الأمانة العامة للحزب، قبل أن يرسو به المآل اليوم على وضع مسافة “نهائية” بينه وبين العمل السياسي العملي والميداني، متحررا من الالتزام الحزبي، وزاده ذلك تحررا في التعبير عن أفكاره السياسية، التي لا يلتزم فيها دائما بلغة التحليل “الباردة”، بل قد تتخلّلها عواطف جيّاشة، كما فعل في الحوار مع “صوت المغرب”، حين أدلى باعتراف حابل بكتلة مشاعر إنسانية فيّاضة عندما قال: “أحب جلالة الملك”.
في خرجاته الإعلامية، قدّم الرميد بعض الإضاءات عن تأسيس الحركة الإسلامية في المغرب، من الشبيبة الإسلامية إلى رابطة المستقبل الإسلامي وحركة الإصلاح والتجديد ثم حركة التوحيد والإصلاح فحزب العدالة والتنمية، كما قدّم بعض التحليلات والمواقف تتعلّق بجماعة العدل والإحسان، وببعض القضايا الخلافية، وفي صدارتها طبيعة النظام السياسي، وضمنه الحديث عن مطلب الملكية البرلمانية.
الرميد، الذي ناقش معي غير ما مرّة بعض مقالاتي السياسيّة حول النظام السياسي المغربي، حرص على أن يستعرض رؤيته لأفق الملكية البرلمانية، بطرحٍ تقاطعَ، بشكل كبير، مع عدد من الأفكار، التي عبّرتُ عنها حول الموضوع، خصوصا ما يتعلّق بجدارة الأحزاب المغربية، التي يفترض أن تنكبّ على مراجعة الذات والتوجّهات وآليات ووسائل وسبل الاشتغال، من أجل أن تلبّي انتظارات عموم الشعب المغربي، وأن تفهم أن المغرب في حاجة إلى أحزاب قوية تكون في مستوى متطلبات اللحظة المجتمعية، وقادرة على تدبير المرحلة وتحصين الممارسة السياسية، ومؤهّلة للارتقاء إلى مرحلة أعلى من الممارسة الديمقراطية، لتكون حاضنة لأفق الملكية البرلمانية.
في هذا السياق، أعتقد أنه من المفيد أن نفرد، هنا، وقفة عند هذا الموضوع (الملكية البرلمانية)، وبالتبعية قضايا (وضع الدستور) و(المجلس التأسيسي) و(البيعة) و(إمارة المؤمنين)، كما وردت في خرجات الرميد الإعلامية، لما لها من أهمية في تحوّلات السياسة المغربية، وانسجاما مع جوهر مقالاتي حول “إلى أين يسير القصر بالمغرب؟”، ذلك أن حديث الرميد عن هذه القضايا وفي ارتباط بجماعة العدل والإحسان، في نظري، له أكثر من دلالة ومن إشارة ومن رسالة، ولا أعتقد أنه يحتمل قراءة بسيطة أو عرَضية كحديث عابر… ولذلك وجب الوقوف عند هذه القضايا.
الرميد وعبد السلام ياسين والمجلس التأسيسي للدستور:
لنعد إلى البدايات، فخلال التجاذبات والتقاطبات الأولى، التي رافقت تشكّل الحركة الإسلامية، سيتحدث الرميد، في حوار “ضفاف الفنجان”، عن علاقة قريبة ومتميزة مع الشيخ الراحل عبد السلام ياسين، إلى درجة أن “المرشد الراحل”، خلال سنة 1982، استقدم الرميد من الدارالبيضاء للاجتماع معه في مراكش، ليعرض عليه الانضمام إلى مجموعته لتأسيس حركة إسلامية، أسماها “أسرة الجماعة”، هي التي ستتحوّل، في مرحلة تالية، إلى “جماعة العدل والإحسان”.
الرميد مضى مباشرة إلى خلافه الجوهري مع توجّهات جماعة العدل والإحسان، فهو لم يتحدث لا عن المرجعيات ولا العمل الدعوي ولا الحركي، إذ أن حجر زاوية الخلاف، بالنسبة للرميد، هو شكل النظام السياسي، أي الملكية وإمارة المؤمنين، ويعتقد الرميد أن العدليين لا يرون، نصب أعينهم، إلا “الخلافة”، لكن مع التشديد من طرف الرميد على أنهم ما داموا لم يخرجوا عن الإجماع الوطني “علانية”، ولا يُؤْذون بلادهم، وهم ضد العنف، فليس هناك أي إشكال في وجود هذا التفكير المخالف، والذي يؤكد الرميد أنه هو نفسه يخالفه جوهريا، مقدما نموذجا لذلك بـ”العتبة”، التي وضعتها الجماعة، والمتمثّلة في مطلب “المجلس التأسيسي”، لوضع دستور جديد للبلاد… يقول الرميد إنها مسألة غير واقعية تجعل “وثيقتهم” مجرّد “منبر للتواصل” لا أكثر، فمطلب المجلس التأسيسي، بحسب الرميد، لا يمكن أن يفتح بابا مع المؤسسات، مشدّدا على أن المجالس التأسيسية لا يمكن إلا أن تكون في سياقات صعبة مثل الثورات أو حروب أهلية أو انفلاتات كبرى.
الرميد سيذهب أبعد من ذلك، ويفترض جدلا أنه في حالة اعتماد خيار المجلس التأسيسي، باعتبار أنه أرقى شكل ديمقراطي، فإن الديمقراطية تفرض تشكّله بالانتخاب، وليس بالتوافق أو التعيين، ليشير إلى أن من سيفوز في هذه الانتخابات، بناء على معطيات الواقع الراهن، هم الأعيان وأصحاب الأموال، وعموما “دهاقنة” الانتخابات، داعيا بذلك إلى اعتماد الواقعية والمساهمة في البناء والإصلاح والتغيير من داخل المؤسسات الدستورية، باعتبار ذلك، كما يرى الرميد، الخيار الأسلم في هذه المرحلة السياسية الدقيقة.
ولعلّ ذلك ما دعا الرميد إلى أن يُصدر ما يشبه “حكم القيمة” على الوثيقة السياسية لجماعة العدل والإحسان، وعلى إمكانية أن تفتح أفقا لانخراط الجماعة في العمل السياسي، حينما اعتبر أنها “غير كافية”! والحال أن المسألة، بالنسبة للجماعة، لا تتعلّق بتقدير لحجم التنازلات وهل ستكون كافية أو غير كافية، بقدر ما تمثّل الوثيقة مرحلة أو محطة من التطوّر الجمعي لتفكير الجماعة في مغرب الغد، ومحاولة استكشاف واستفتاح لأبواب تتيح مشاركة جميع المغاربة في تقرير حال مغرب اليوم ومآل مغرب الغد، كما سبق التنويه بذلك في مقالي عن دولة ولي العهد وشباب جماعة العدل والإحسان، وفي ما طرحته الوثيقة السياسية من مواقف تكاد تتطابق مع التوجّهات والتوجيهات الملكية، من قبيل الانتقادات اللاذعة، التي يوجّهها الجالس على العرش إلى الأحزاب المغربية.
الملكية البرلمانية وتطور النظام السياسي المغربي:
الانتقادات الموجهة إلى الأحزاب، في نظري، هي التي دفعت الرميد إلى القول، في حواره مع “صوت المغرب”، إن النظام السياسي المغربي القائم هو ما يستحقّه المغاربة اليوم، قبل أن يمضي مباشرة إلى عوائق قضية “الملكية البرلمانية”، على أساس أن “المعضلة” تتمثّل في ما يمكن أن أسميه “البنية التحتية الأساسية” للملكية البرلمانية، وهي الأحزاب السياسية، التي قال الرميد، كما قلنا ذلك مرارا، إنها غير مؤهّلة، وتساءل بإنكار: هل نؤسس الملكية البرلمانية على فراغ؟ هذا الأفق، أي الملكية البرلمانية، في حاجة إلى أحزاب حقيقية ونقابات حقيقية وصحافة حقيقية ومجتمع مدني حقيقي، يقول الرميد قبل أن يتابع مستدركا: “مازلنا نتلمّس طريقنا في بناء المؤسسات، التي يجب أن يتأسس عليها أي تطور نوعي للنظام السياسي”، وضمن هذه المؤسسات، طبعا، الأحزاب المغربية.
هذا الوضع “المخنوق”، الذي توجد عليه الأحزاب، يطرح، كذلك، مسؤولية “السلطة” على هذا المآل، فالأحزاب المغربية تخضع للسلطة، وتحديدا لوزارة الداخلية… والنموذج الأبرز، هنا، هو التأريخ الذي قدّمه الرميد، كما حكاه في خرجاته الإعلامية، لظهور وتشكّل الخلايا الأولى لإسلاميي المغرب، والذي يستعرض فيه ظروف الاتصالات، التي كان قادة الحركة الإسلامية يجرونها مع وزارة الداخلية، ومنها حديث الرميد عن “أول تواصل” له مع إدريس البصري، خلال النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي، وكيف راسل وزير الداخلية القوي، آنذاك، مستأذنا إجراء “لقاء” مع مسؤول من السفارة الفرنسية، أعقبها إنجاز “تقرير” حول اللقاء رفعه الرميد للبصري، قبل أن يستدعيه هذا الأخير لـ”يناقش” معه آفاق حركتهم الإسلامية، كما تطرّق الرميد إلى عملية “التوحيد” بين “رابطة العمل الإسلامي”، التي كان الرميد والريسوني من أبرز قادتها، وبين “حركة الإصلاح والتجديد”، التي كان يتزعّمها عبد الإله بنكيران، في إطار حركي جديد باسم حركة التوحيد والإصلاح… وفي هذا التأريخ، ستغيب العديد من التفاصيل والمعطيات، حول خلفية ظهور الوليد الجديد، حزب العدالة والتنمية، الذي تأسس من قِبَل “إسلاميي المخزن” بتوجيه ومباركة من طرف السلطة.
رسائل الرميد إلى إخوان محمد عبّادي:
الحكاية، التي رواها الرميد عن البصري وطرحه لموضوع “الإسلاميين” مع الملك الراحل الحسن الثاني، مهمة جدا ليس فقط من الزاوية التأريخية، ولكن أساسا لرسالتها السياسية. فقد سأل الحسن الثاني وزيره القوي: “كم سيحصلون من مقاعد إذا دخلوا الانتخابات؟”، أجاب البصري: “بين ثمانية وعشرة مقاعد”، فأذن له الحسن الثاني… كان الرميد يشير إلى مشاركة سياسية “مراقَبَة”، دون استعمال صريح للكلمة، ليبيّن، وفي هذا البيان “رسالة تحت الماء” يوجّهها لجماعة العدل والإحسان، أن الحزب الذي بدأ محتشما، ثم دخل البرلمان هامشيا، سرعان ما سيتبوّأ المشهد السياسي، ويتولّى رئاسة الحكومة، خلال ولايتين متتاليتين، من خلال تفاعله الإيجابي مع تحوّلات وتطوّرات المرحلة السياسية.
نفس “الرسالة” سنجدها في حديث الرميد عن “الملكية البرلمانية”، وكيف كان من أشد مؤيديها في بداية التسعينيات، ليقول إنه بعدما خبر الكثير من المعطيات والتطوّرات، أصبح له موقف مغاير، واقعي وعقلاني، يأخذ بالاعتبار المصلحة العليا للمغرب والمغاربة… وتحوّل ما كان يصفه، هو وبنكيران وإخوانه الإسلاميون، بـ”الدولة العميقة”، أو “العفاريت والتماسيح”، إلى “نعمة”، جاد بها الله على البلاد، وفي هذا إعادة قراءة لتاريخ تأسيس “البيجيدي”، الذي لم يكن مفروشا بالورود، إذ اكتنفته العديد من محطّات التوتّر مع السلطة، أو حتى مع القصر، كما جرى تصريفها، مثلا، في محطتي إقالة (استقالة) الرميد من رئاسة الفريق البرلماني، وكذا إقالة (استقالة) أحمد الريسوني من رئاسة حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لـ”البيجيدي”، عندما “أفتى” بعدم “شرعية” الملك محمد السادس لخلافة الملك الراحل الحسن الثاني في “إمارة المؤمنين”، ما دعا الأمانة العامة للحزب، بضغط من القصر، إلى التحرّك على عجل وإرغام الريسوني على الاستقالة من رئاسة الحركة، وفق ما ذكرتُ في مقال سابق، كنت تعرضتُ فيه لهذه الواقعة، التي كنت شاهدا على بعض فصولها ومحطاتها.
سماح نظام الحسن الثاني بدخول هؤلاء الإسلاميين إلى السياسة، كان مقابل “الخضوع” لأجندة القصر، ليكونوا عونا له في مواجهة القوى اليسارية، التي كانت فئة منها تسعى إلى الإطاحة بالنظام الملكي… وأن هذه الأجندة هي التي كانت وراء غضبة القصر على الرميد نفسه.
الملكية البرلمانية وغضبة القصر على الرميد ومناصرة العدل والإحسان:
حاول الرميد، في خرجاته الإعلامية، تفادي الوقوف عند غضبة القصر عليه، إذ اكتفى بالقول: “الدولة كانت لديها قراءة معينة لأداء الرميد، وكانت ترى أنه ليس ذلك المسؤول، الذي يصلح لأن يكون في الواجهة بالنسبة لحزب إسلامي”.
لكن ما لم يقله الرميد، هنا، أن غضبَ القصر عليه ودفعَه إلى الاستقالة من رئاسة الفريق البرلماني للبيجيدي سنة 2003، كانت بسبب تصريحاته المؤيدة، أحيانا، لموكّليه المتهمين في الاعتداءات الإرهابية ليوم 16 ماي، في ما عُرف بتيار السلفية الجهادية، إلى حد أنه اتهم الدولة بالوقوف وراء التفجيرات الإرهابية، إضافة إلى تصريحاته ومطالباته المتعددة بـ”الملكية البرلمانية”.
في هذه المحطة الدقيقة، التي تداعى فيها البيجيدي إلى التبرير والدفاع لامتصاص “غضب المخزن”، سيجد الرميد مناصرة قوية من جماعة العدل والإحسان، وسينبري الموقع الرسمي للجماعة للدفاع عنه، معتبرا أن “جريمة مصطفى الرميد، المغضوب عليه لدى السلطات العليا، هي تجرُّؤه عندما قال في إمارة المؤمنين برأي يخالف المسلمات المخزنية”. ويورد الموقع ما قاله الرميد حرفيا، مقتطعا من ورقة منشورة بعنوان “تدقيق المقالة في ما ينبغي أن يكون بين الإسلام والملكية والديمقراطية من علاقة”، قال فيها الرميد بالحرف إن “صفة إمارة المؤمنين لا تمنح صاحبها سلطات مطلقة، ولا تجعل منه معصوما غير قابل للمساءلة في منظور الإسلام إذا تحمّل مسؤولية من مسؤوليات التشريع أو التنفيذ أو غيرها… ولذلك، فإن إمارة المؤمنين والبيعة، تبعا لها، لا ينبغي أن تفهم على أنها تتيح سلطات تتجاوز أحكام الدستور والقانون”، ليتساءل الموقع: “أين هو العيب في كلام الأستاذ الرميد، الذي يُعدّ في طليعة الإسلاميين المدافعين عن إمارة المؤمنين؟”.
والمثير، هنا، أن تحفّظ القصر لم يطوه النسيان ولا “بركات” 20 فبراير على العدالة والتنمية، فقد أُثير التحفّظ من جديد حول الرميد عندما اقترحه بنكيران لتولّي حقيبة العدل في حكومة البيجيدي الأولى، إذ ظل اقتراحه للاستوزار معلّقا ولم يقع إلغاء التحفظ إلا بعد أزيد من أسبوع عندما اتصل فؤاد عالي الهمة بعبد الإله بنكيران ليخبره أن الملك حقّق في القضية، وتأكد له أن الموضوع المُثار حول الرميد غير صحيح.
كانت هذه القضية طبيعية لأن كلاما كثيرا كان يُثار حول الرميد، وكانت تصريحاته تثير الكثير من الجدل، ومن ذلك، مثلا، أنه كان “الإسلامي”، دون باقي إخوانه وقومه، الذي يرفع باستمرار المطلب، الذي كان يرفعه اليسار الماركسي، حول “الملكية البرلمانية”، منذ المشاركة في المشهد السياسي المغربي نهاية تسعينيات القرن الماضي، وبالخصوص في ظرفية “ربيع” 2011 وتظاهرات حركة 20 فبراير، وفي نفس الوقت كان الرميد من أكثر المتحمّسين لخطاب الملك محمد السادس ليوم 9 مارس، الذي رأى فيه “قاعدة لتأسيس ملكية برلمانية”، وأنه أسّسَ لـ”عهد ملكي جديد”.
اللافت أن الرميد كان غير بعيد عن المناخ العام، الذي سوّقه الملك، الذي يخطط لأن “يسود ولا يحكم”، عبر مستشاريْه عبد اللطيف المنوني وعمر عزيمان، ففي الوقت نفسه (الأسبوع الأخير من يوليوز 2019)، وعشية الاحتفال بالذكرى العشرين لعيد العرش (30 يوليوز)، سيقول المستشاران الملكيان: “نحن على طريق ملكية برلمانية”، وسيقول الرميد، وهو آنذاك وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان: “لسنا دولة مستبدة والمغرب يسير نحو الملكية البرلمانية”.
وإذن، فإن ما لم يقله الرميد، وكان من شأنه أن يكشف كل أسباب “غضبة” القصر عليه، هو ما دار في اجتماع بالرباط، في يوليوز 2003، وفي ظل مضاعفات التفجيرات الإرهابية في الدارالبيضاء (16 ماي)، بمنزل وزير الداخلية حينئذاك مصطفى الساهل، وكان مرفوقا بالوزير المنتدب لدى وزير الداخلية آنذاك فؤاد عالي الهمة، الذي قرّع كلا من الريسوني والرميد، اللذين استُدعيا للاجتماع، على مواقفهما وتصريحاتهما: الريسوني بتشكيكه في شرعية الملك محمد السادس في إمارة المؤمنين، والرميد بـ”دزينة” مواقف، أولاها بعض تصريحاته المتماهية مع دفاعه عن معتقلي السلفية الجهادية، وثانيها بعض تصريحاته “المزعجة”، آنذاك، عن “الملكية البرلمانية”، تفيد نوعا من “التشكيك في المؤسسات”، وثالثها، وأساسا، تأييده للريسوني في اجتماع لقيادة حزب العدالة والتنمية خُصّص للتعامل مع مضاعفات تصريحات رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الذي سيتولّى، بعد ذلك، رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ويغادر المغرب ويستقر في قطر، وتختفي معه تصريحاته المشكّكة في شرعية إمارة المؤمنين، التي ارتبطت بكل ملوك المغرب عن طريق “البيعة”.
البيعة وأمير المؤمنين وأمير المسلمين:
ارتبطت “البيعة”، باستمرار، بنظام الحكم الملكي “العربي” في المغرب، الذي ابتدأ مع دولة الأدارسة (788-974م)، وبُنيت الأصول الدينية والشرعية للبيعة على المذهب المالكي، الذي استقدمه معه مؤسس الدولة إدريس الأول، الذي يعود نسبه إلى الأسرة العلوية (إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب)، وشكّلت البيعة عقدا دينيا وسياسيا بين “الرعية” وبين “الحاكم”، وهو النهج، الذي مضت عليه مجمل “الدول” أو “الأسر”، التي تداولت على حكم المغرب (باستثناء الدولة المرابطية، لافتقادها إلى الانتساب إلى “آل البيت النبوي الشريف”، إذ رفض مؤسسها يوسف بن تاشفين حمل لقب “أمير المؤمنين” بداعي أنه أمازيغي صحراوي، وأن هذا اللقب لا يحمله إلا من هو متحدّر من السلالة النبوية، ليختار لنفسه لقب “أمير المسلمين”)، وصولا إلى الدولة العلوية الحالية.
حتى أن التهامي الكلاوي، عندما أراد الخروج عن السلطان (الملك) محمد بن يوسف، وكان ذلك يوم 23 دجنبر 1950، وكان السلطان، كما جرت العادة، يستقبل الوفود في فاس من كل أنحاء وجهات المغرب، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي، حيث تقدّم له الوفود البيعة، وكان على رأسهم الباشا التهامي باعتباره الرجل الثاني في البلاد بعد السلطان، وكان أيضا صهر الصدر الأعظم محمد المقري، ومستقويا بتأييد مسؤولي سلطات “الحماية”، وعندما لاحظ أن السلطان يقرّب إليه وفد حزب الاستقلال وهو ألدّ أعدائه، لم يتمالك نفسه أن “نهر” السلطان، وقال له: “لستم إلا ظل سلطان، لم تعودوا سلطان المغرب، أنتم سلطان حزب الاستقلال”، فكانت غضبة قوية من السلطان محمد الخامس، حيث طرده على الفور من القصر.
فعاد الكلاوي أدراجه، وصرف وفود قبائله حتى لا تقدّم تجديد البيعة، ثم وصلت الأمور إلى حد تجييش 270 توقيعا لباشوات وقواد على عريضة 19 ماي 1953، يتحلّلون فيها من البيعة، ويعلنون “إخلاصهم” للحماية الفرنسية، ومطالبتهم بـ”إبعاد” السلطان محمد الخامس.
كانت “البيعة” عمليا هي دستور البلاد، مع فارق أنها تعتبر “فوق دستورية”، ولذلك، لم يضمّنها واضعو مشروع دستور 1908 ضمن مقتضياته المؤطّرة لنظام الحكم في المغرب، وكان سيكون الحال كذلك أيضا في أول دستور سيعرفه المغرب سنة 1962، إذ أن مسودة الدستور، في البداية، التي وضعها خبراء فرنسيون، باستناد إلى تجربة وضع دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا سنة 1958، جاءت خالية من أي إشارة للبيعة ولإمارة المؤمنين، إلى أن تدخّل الدكتور عبد الكريم الخطيب لينبه الملك الحسن الثاني إلى ضرورة النص على البيعة وإمارة المؤمنين في دستور المملكة، حسب الروايات الشائعة.
على مسؤوليتي
سعيد الكحل: جيلz والحاجة إلى الاستثمار في الإنسان
نشرت
منذ 4 ساعاتفي
أكتوبر 7, 2025بواسطة
سعيد لكحل
شكلت احتجاجات جيلZ Gen في المغرب مفاجأة للدولة وللأحزاب وللرأي العام. وسبب المفاجأة يكمن في الجهل التام بما يجري في العالم الافتراضي ومواقع التواصل الاجتماعي.
لقد اكتشف المغاربة، مسؤولون ومواطنون، أن جيل z تشكل وعيه السياسي خارج الأطر التقليدية من أحزاب وجمعيات ونقابات. الأمر الذي عقّد مهمة التواصل والحوار معه، وخلق انطباعا عاما لدى أعضاء الحكومة بأنه جيل هلامي مجهول الهوية والقيادة والكيان المادي؛ إلا أنه قابل للتمدد والتشكل على أرض الواقع. جيل يرفض الإطارات الحزبية والحكومية ويتجاوزها إلى إملاء مطالبه على الدولة تحت التهديد بالاحتجاج المفتوح على الزمان والمكان. أي لا يضع سقفا زمنيا لحركته الاحتجاجية ولا يقيدها بأماكن معينة (شوارع، ساحات عمومية). وباعتباره جيلا هلاميا في بنيته التنظيمية وفي مطالبه، فإن مساحات احتجاجاته رهينة بمزاجيه المتفاعلين في الغرف المظلمة داخل تطبيق “ديسكورد”.
أي أن احتمالية توسيع مداها واردة وقد خرجت أصوات تحرض على تغيير وجهتها نحو الأماكن الحساسة. وإذا كان جيلZ Gen أظهر تشبثه بالمؤسسة الملكية ووجوب إحداث الإصلاح في ظلها وبيدها، وهذا أمر مهم يعكس حرصه على صيانة المكتسبات السياسية والدستورية وكذا صموده في وجه دعاوى العنف والتخريب، فإن الاطمئنان إليه لا تدعمه لائحة مطالبه وهلاميتها وتجاوزها للأطر الدستورية والقواعد الديمقراطية المتعارف عليها. الأمر الذي يسمح بالاستنتاج أن جيلZ Gen “تشابه عليه البقر” ولم يعد يميز بين العالم الافتراضي المتحرر من كل القيود والإكراهات والحتميات، وبين العالم الواقعي (السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي) الأشد تعقيدا على الفهم والتغيير معا. إذ لا يكفي التعبير عن المطالب الاجتماعية التي يُجمع عليها المغاربة، لكي يفرض هذا الجيل z وصايته واختياراته على الشعب. ذلك أن المطالبة بحل البرلمان وإقالة الحكومة وحل الأحزاب تجسد “تشابه البقر” عليه.
فكما يتعامل مع الألعاب الإلكترونية التي تَمرّس عليها في تطبيق “ديسكورد”، أراد أن يتعامل بالمثل مع مكونات الحياة السياسية وركائز الدولة المغربية. إن الديمقراطية ليست لعبة الكترونية نتحكم فيها وفق مزاجنا، بل هي دينامية سياسية واجتماعية وحضارية تنخرط فيها كل مكونات المجتمع وفق قواعد ومبادئ متعارف عليها كونيا.
الاستثمار في الإنسان.
إن احتجاجات جيلZ Gen تضع الدولة والحكومة والأحزاب أمام مسؤولياتها، وفي مقدمتها عدم الاستثمار في الإنسان، بحيث لم تجعل المواطن في جوهر اهتمامها ومحور برامجها. من هنا تم الإجهاز على القطاعات العمومية في التعليم والتكوين والصحة بمبرر أنها قطاعات غير منتجة. وحين رفعت الدولة يدها على الصحة والتعليم والثقافة، فتحت المجال للوبيات المدارس الحرة والمصحات الخاصة لتحويل الخدمات الاجتماعية إلى مجال للمضاربات والاحتكار والاتجار بعقول وصحة المواطنين، أي الاتجار بالبشر الذي يجرمه القانون. إلا أن غياب تطبيق القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة الذي تتحمل مسؤوليته الحكومة، سياسيا ودستوريا وأخلاقيا، حوّل المواطن من قيمة أخلاقية مطلقة إلى سلعة يحدد قيمتها السماسرة والمحتكرون. وما يزيد الوضع خطورة هو عجز الحكومة عن حماية المواطنين عبر تحديد أسعار الدراسة بالقطاع الخاص وتعريفة العمليات الجراحية والتدخلات الطبية في المصحات الخاصة. وهو نفس التوجه الذي نهجته وتنهجه الحكومات في قطاع المحروقات، منذ تحرير الأسعار؛ حيث فضلت موقع المتفرج بدل تسقيف الأسعار وردع الاحتكار. بل إن الحكومة، باعتراف من وزير الصحة، ظلت تمنح دعما ماليا للمصحات الخاصة.
لقد تعاملت الحكومة ومعها الأحزاب المكونة لها وتلك التي تتولى تسيير المجالس الترابية، بكل استهتار بمطالب المواطنين بتحسين الخدمات الاجتماعية وترشيد النفقات وتوجيهها لما يخدم المصلحة العامة. كما تجاهلت ــ الحكومة ــ مطلب تفعيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة، سواء تعلق الأمر بالإثراء الغير مشروع، أو تجميد تقارير المجلس الأعلى للحسابات في قضايا تتعلق بنهب المال العام وتبذيره، أو حماية الفاسدين وإعادة تدويرهم في المسؤوليات.
هذا الوضع لم يزد المواطنين إلا غضبا عبروا عنه بسلسلة من الاحتجاجات التي كانت بمثابة ناقوس خطر لم تتعامل معه الحكومة بالجدية المطلوبة. ولم تكد تهدأ احتجاجات ساكنة المناطقة المهمشة حتى خرج جيلZ Gen من حيث لا تحتسب الحكومة.
لا تُهزم الأوطان بقوة أعدائها بل بخيانة أبنائها.
إن تخلي الدولة عن مسؤولية التربية والتعليم والتأطير عبر المؤسسات التعليمية والثقافية (إهمال دور الشباب، عدم توسيع شبكتها لتواكب النمو الديمغرافي والتوسع العمراني)، وكذا استقالة الأسر من أدوار التنشئة، أخرج أجيالا متنافرة القيم والقناعات. ولعل تورط القاصرين في أعمال التخريب والنهب بنسبة 70 % من الموقوفين خلال احتجاجات جيلZ Gen، دليل يعكس خطورة إهمال التربية على القيم الأخلاقية وعلى المواطنة في خلق جحافل من المخربين لا وازع وطني أو ديني أو أخلاقي أو قانوني لهم (ظهر، في فيديو تخريبي، تلميذ بوزرته البيضاء، يكسر زجاج سيارة الدرك الملكي وعلى ظهره محفظته).
إن من شأن عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة والإفلات من العقاب، والتخلي عن الأدوار التربوية والتعليمية للمدرسة والأسرة، أن يوفر بيئة مناسبة للفساد، وذهنية ميّالة إلى العنف والتخريب والخيانة الوطنية. والخيانة لا تنحصر فقط في التخابر مع الأجنبي، بل تتخذ أشكالا عدة، منها: خيانة المسؤولية التمثيلية سواء في البرلمان أو في المجالس المنتخبة، خيانة المسؤولية الإدارية أو المهنية سواء بالإخلال بالواجب المهني أو التستر على الفساد أو التواطؤ مع المفسدين. وقد تجسدت هذه الخيانة في القطاع الصحي بشكل كارثي.
وحتى لا يجرف تيار الخيانة جيلZ Gen ، على الشباب وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والاحتياط من دعاوى تصعيد الاحتجاج وتوسيع مداه إلى المؤسسات والمواقع الحساسة؛ إذ خلف تلك الدعاوى تشابكت أيادي الغدر والعداء بخيوط التآمر ومخططاته التي تستهدف نهضة المغرب ومشاريعه الاقتصادية والصناعية والعسكرية، فضلا عن وحدته الترابية واستقراره السياسي. إننا أمام صراع النفوذ تستعمل فيه الأسلحة السيبرانية (20 ألف حساب الكتروني وهمي يحرض على العنف في المغرب) والإعلامية (قنوات فضائية، صفحات الكترونية، صحف دولية جعلت من احتجاجات جيلZ Gen موضوعها الرئيسي)؛ لذا وجب رفع منسوب الوعي الوطني الجماعي للتصدي لكل المؤامرات وإفشال كل المخططات العدائية.
ما العمل؟
إن الواجب الوطني والدستوري يوجب على الحكومة الإسراع باتخاذ الإجراءات التالية:
1 ـ تفعيل الدستور بربط المسؤولية بالمحاسبة عبر الشروع في تقديم الملفات إلى القضاء، مع تسريع مسطرة البت فيها.
2 ـ إصدار قانون تجريم الإثراء الغير مشروع والبدء في تطبيقه.
3 ـ تشكيل لجان تفتيش محلية وإقليمية وجهوية مهمتها الوقوف على الأوضاع الصحية والإدارية في المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات.
4 ـ فتح خط أخضر يسمح للمواطنين رفع شكاواهم وتظلماتهم إلى وزارة الصحة.
5 ـ تجهيز وتأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات وتوفير الأدوية الضرورية للمرضى.
6 ـ توفير الأطر الطبية والتمريضية الضرورية، وإن اقتضى الأمر جلبها من الخارج (السنغال، تونس).
7 ـ تحديد أسعار العمليات الجراحية والخدمات الصحية في المصحات الخاصة.
8 ـ إجبار المصحات الخاصة بتقديم الخدمات الصحية للمرضى المؤمّنين وأصحاب AMO بأسعار متقاربة مع أسعار القطاع العمومي.
9 ـ وقف الدعم المخصص لكبار الفلاحين ولمالكي الشاحنات والحافلات والتاكسيات تحت ذريعة تجديد أسطول المركبات لتقليل نسبة التلوث، وتوجيهه إلى قطاع الصحة العمومية لتجويد الخدمات.
10 ـ وقف الدعم عن الأحزاب حتى تجدد دماءها بالعناصر الشابة وتقوم بمهامها التأطيرية والتوعوية.
ليكن الحافز الرئيسي للحكومة وللأحزاب، في هذه الظرفية الدقيقة شعار ( تشيغيفارا) :
“لا يهمني أين ومتى سأموت بقدر ما يهمني أن يبقى الوطن”.
على مسؤوليتي
الاحتجاجات الشبابية بين المشروعية والتوظيف السياسي: دعوة إلى تفعيل المجلس الاستشاري للشباب
نشرت
منذ 7 ساعاتفي
أكتوبر 7, 2025بواسطة
حسن لمزالي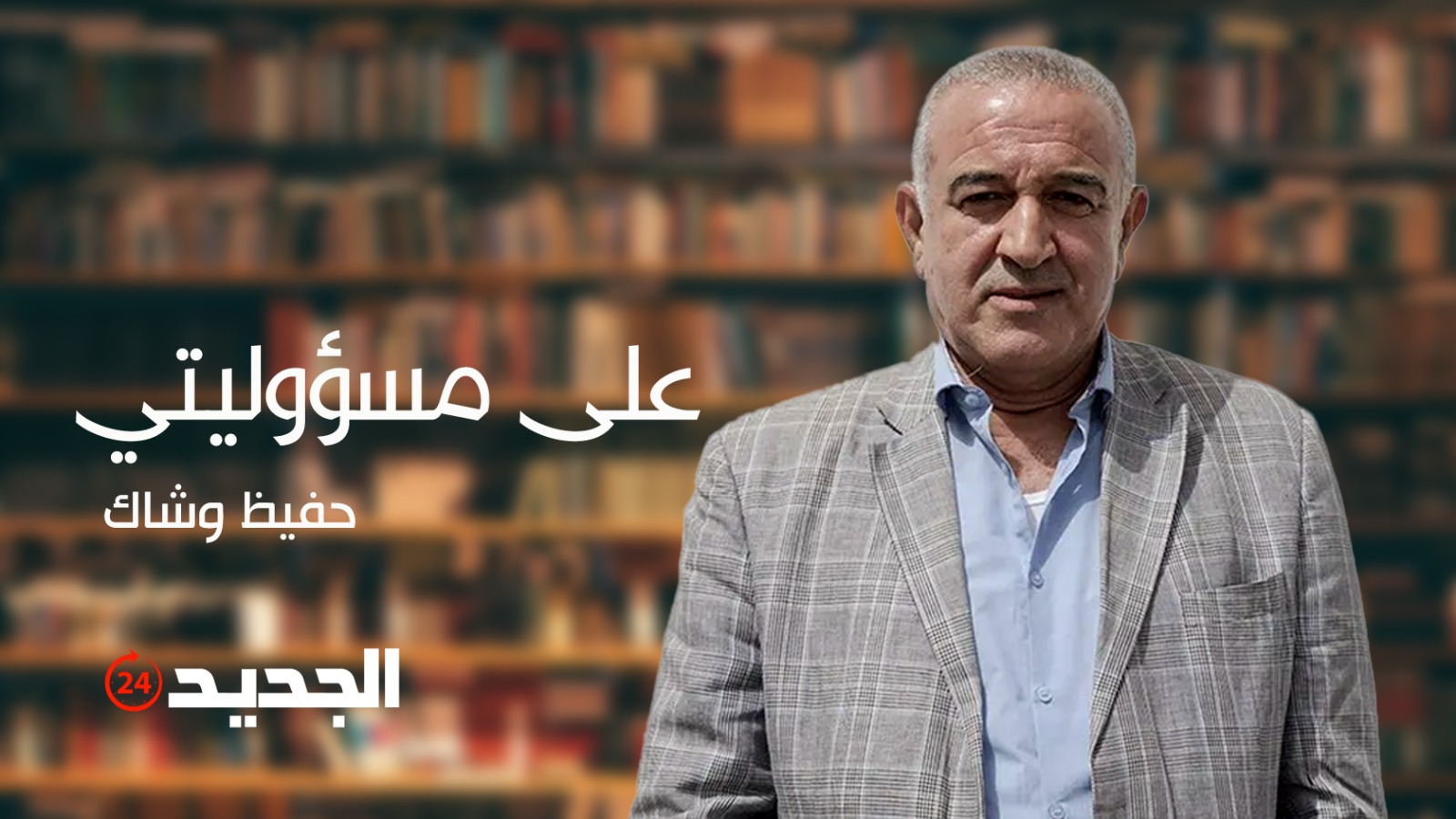
تشهد الساحة الوطنية في الآونة الأخيرة، حراكاً شبابياً متزايداً، تُرفع فيه شعارات تتعلق بالصحة والتعليم وفرص الشغل وتحسين الخدمات العمومية. وهي مطالب مشروعة ودستورية تعبّر عن وعي متنامٍ لدى الشباب المغربي، وعن رغبة صادقة في بناء مستقبل أفضل يتماشى مع تطلعاتهم وكرامتهم الاجتماعية.
غير أن المراقب الموضوعي لا يمكنه أن يغض الطرف عن تداخل البعد السياسي في بعض هذه التحركات، إذ أصبح من الواضح أن هناك محاولات لتوظيف الاحتجاجات في إطار تصفية حسابات مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، الذي يقود منذ بداية ولايته اوراشا تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات الحيوية.
لقد نجحت الحكومة الحالية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إطلاق مشاريع كبرى تهم المواطن مباشرة، من إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية، إلى تحسين ظروف التعليم ودعم التشغيل الذاتي للشباب، فضلا عن الاستثمار في الفلاحة والبنية التحتية.
هذه الإنجازات الملموسة جعلت البعض ممن فقدوا وزنهم السياسي يحاولون تحريك الشارع تحت غطاء المطالب الاجتماعية، في حين أن الهدف الحقيقي هو إضعاف الحكومة وضرب مصداقية العمل للمؤسسات.
إن مواجهة هذه التحديات لا تكون بالتجاهل أو القمع، بل بالحوار والتفاعل الجاد. وهنا تبرز الحاجة الملحّة إلى تفعيل مؤسسة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، التي نص عليها دستور 2011، كآلية مؤسساتية للحوار وإشراك الشباب في رسم السياسات العمومية التي تخصهم.
لقد آن الأوان لأن يتحول هذا المجلس من فكرة دستورية معلّقة إلى واقع فعلي يعبّر عن صوت الشباب المغربي ويجمعهم في فضاء مؤطر ومؤسساتي، بعيداً عن الاستغلال السياسي أو الفوضى العاطفي.
إن تفعيل هذا المجلس سيتـيح للدولة آلية حضارية للتواصل مع الشباب، وسيساهم في تهدئة التوتر الاجتماعي عبر تحويل المطالب إلى مقترحات بنّاءة، والأصوات الغاضبة إلى طاقة اقتراحية تساهم في التنمية.
ان المغرب اليوم في حاجة إلى شباب فاعل ومسؤول، لا إلى شباب منساق وراء دعوات مغلوطة تحركها أياد خفية تكن العداء للمملكة، وتسعى إلى زعزعة استقرارها الراسخ بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وبين الاحتجاج والمشاركة، يظل الخيار الواضح أمام الجميع هو الحوار الوطني الهادئ، في إطار المؤسسات، ومن خلال تفعيل المجلس الاستشاري للشباب، باعتباره الجسر الحقيقي بين الدولة وشبابها.
* الدكتور حفيظ وشاك
عضو الفدرالية الدولية لصحافيي
وكتاب السياحة
على مسؤوليتي
أزمة الوساطة السياسية بالمغرب.. حين تفرض احتجاجات “جيل Z” قواعد اللعبة الانتخابية
نشرت
منذ يومينفي
أكتوبر 5, 2025بواسطة
مراد بورجى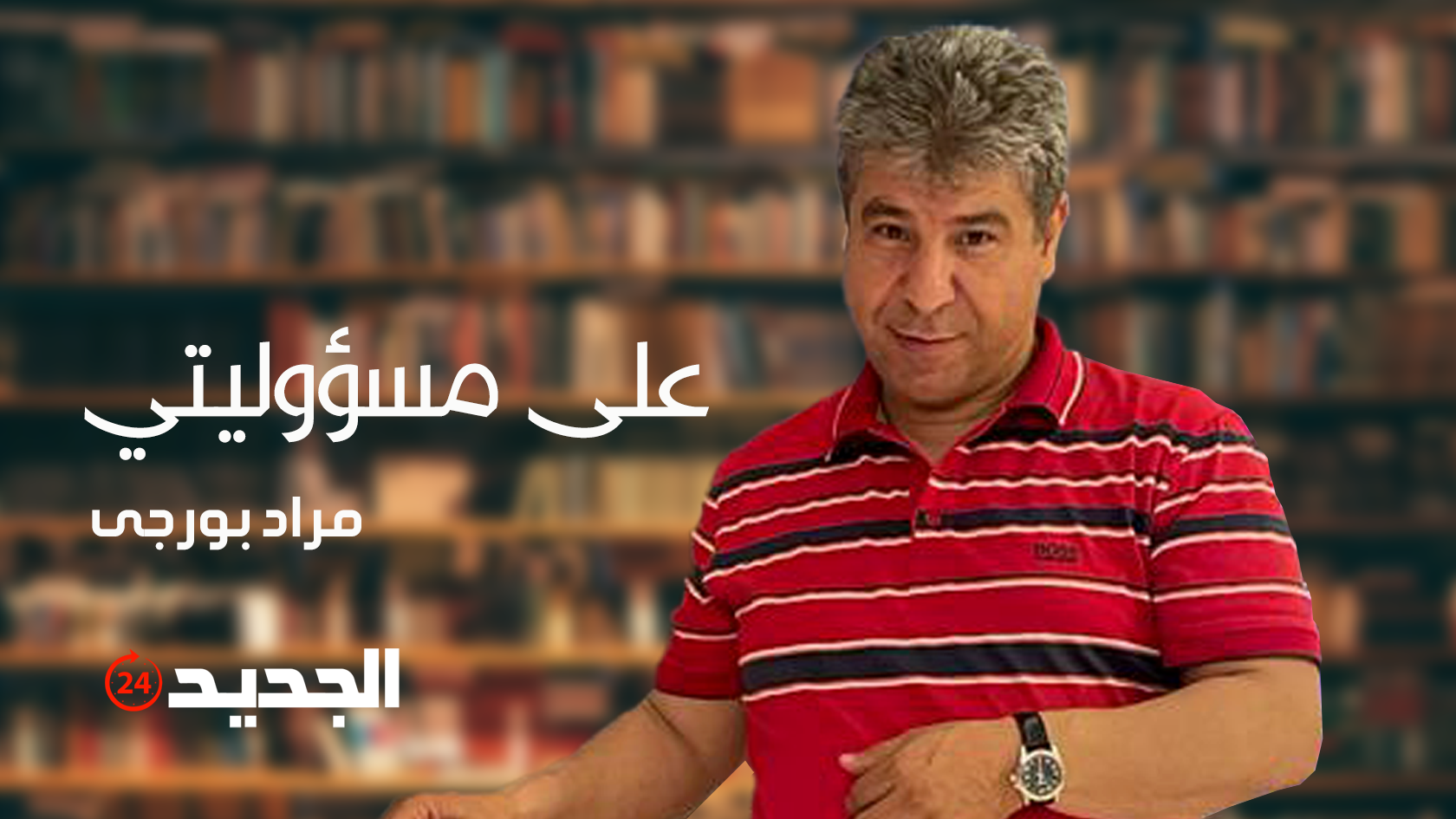
* مراد بورجى
شهدت الساحة المغربية، منذ يوم السبت الماضي (27 شتنبر 2025)، موجة جديدة من الحراك الاجتماعي، بطلها “جيل زد 212″، الذي يمثّل الفئة العمرية، التي ولدت في أواخر التسعينيات وبداية الألفية الجديدة. هذا الجيل الذي ترعرع في فضاء رقمي مفتوح، يختلف عن الأجيال السابقة في أدواته وأساليبه ورهاناته، وهو ما يجعل احتجاجاته اليوم موضوعا سياسيا بامتياز، يفرض على الدولة والأحزاب والنخب مقاربة جديدة لفهمه والتفاعل معه، مع الاستفادة من بعض خلاصات تجربة حركة 20 فبراير ربيع 2011.
خلافاً لما شهدته حركة 20 فبراير سنة 2011، لا تقف وراء احتجاجات “جيل Z” تنظيمات سياسية أو نقابية كما عبّروا عن ذلك. بل إن مصدرها الأساس هو التفاعل الرقمي على منصات مثل “ديسكورد” و”تيك توك” و”إنستغرام”، حيث يتحول الغضب الاجتماعي إلى دعوات جماعية للنزول إلى الشارع. هذه الطبيعة اللامركزية، التي تبدو عفوية في الظاهر، هي في الواقع انعكاس لأزمة الوساطة السياسية في المغرب، التي طالما حذّرتُ منها في مقالاتي: لقدْ فَقَدَ الشباب الثقة في الأحزاب والنقابات والجمعيات التقليدية، واختاروا أن يصنعوا فضاءهم البديل بأنفسهم. خصوصا أن الأحزاب المغربية ذاتها، بمختلف تلاوينها، وضعت نفسها محلّ تشكيك هؤلاء الشباب وكرّست فقدان ثقتهم فيها، من خلال ما أصدرته من بيانات رتيبة، تتراوح بين تعبيرات التضامن ومحاولات الاستعمال والتوجيه، معبّرةً بذلك عن فشلها في فهم صيرورة وتوجهات هؤلاء الشباب، وفي إدراك أن شباب “20 فبراير”، الذي كان يتواصل بالفايسبوك، ليس هو شباب “جيل Z”، الذي يتواصل بأساليب رقمية حديثة، معنى ذلك أن الفاعلين الحزبيين لم يدركوا بعد أن لكل زمن جيله، ولعل أبلغ برهان على هذا الوضع هو هذا الإصرار “المرضي”، لدى هؤلاء الفاعلين، على “القبض” على الكرسي والعضّ عليه بالنواجذ على امتداد الزمن، ليس بالسنوات فحسب، بل بحساب العقود، إذ كيف يمكن تصور وجهٍ حزبي يُنتخب في برلمان 1993 مثلا، ويبقى يُنتخب في كل ولايات الاستحقاقات الانتخابية، وها هو اليوم “موجود” في برلمان 2021-2026!!! .
في المحصلة، يبدو وكأن الزمن السياسي توقّف عند هذه الوجوه الحزبية الرتيبة والمكرورة، محطّمين منطق التاريخ ومنطوقه، الذي يفيد أن لكل زمن نساؤه ورجاله وشبابه، وأنه آن الأوان ليستيقظوا على الحقيقة المرة: أن “جيل Z” غير معني بوجوههم وملامحهم، ولا بكل النظرات والنظريات والتحقيبات والتصورات التقليدية عن الحركة الوطنية، وعن اليمين واليسار، وعن القومجية والماركسية، وعن أبطال وضحايا وجلادي سنوات الرصاص…، كل هؤلاء الوجوه لا يعنون شيئا لهؤلاء الشباب المحتجين، الذين ظلوا يحرصون على التأكيد، بمناسبة وبغيرها، أنهم لا ينتمون لأي حزب، ولا يؤطّرهم أي تنظيم وليس لديهم أي قيادات معروفة، الأمر الذي يعقّد أكثر كل حوار منشود معهم لصعوبة اعتراف الآخرين بما يمكن أن يترتّب عنه من نتائج وبرامج وقرارات…
١وبالتالي، كل ما هو متوفر بين أيدينا لائحة مطلبية تتضمّن 30 مطلبا، أعلنوا عنها يوم الخميس في بلاغ تعليق الاحتجاجات، واللافت في المطالب أنها خلت تماماً من أي نزوع سياسي صدامي، فلا دعوات لإسقاط الحكومة ولا شروط لإعادة تشكيل المؤسسات، بل مطالب اجتماعية صرفة: تعليم جيد ومجاني، سد خصاص الأساتذة، رقمنة المناهج، نقل مدرسي محترم، تعزيز الصحة العمومية، تخفيض أسعار الدواء، توفير السكن اللائق، تحسين الأجور، محاربة الاحتكار، ودعم المقاولات الصغرى. هذه ليست شعارات فضفاضة، بل قضايا ملموسة تمس حياة المواطن اليومية في القرية والمدينة معاً. وهنا تكمن قوة اللائحة: إنها مطالب تتجاوز حدود الجيل لتصبح خطاباً وطنياً شاملاً.
غير أنه مع إطلالة صباح اليوم الجمعة 3 أكتوبر الجاري، ستخرج حركة “جيل زد 212″، على موقعها، الذي أحدثته بالفايسبوك، بلائحة مطالب جديدة مرفوقة بالتنبيه التالي: “المطالب المنشورة مسبقا لا تعتبر المطالب الرسمية النهائية، كما أنها لا تشمل الصيغة الرسمية المناسبة، نرجو عدم نشرها باعتبارها أساسية إلى حين نشرها بصيغة رسمية”، وهي مطالب توجّهت مباشرة إلى المؤسسة الملكية تطلب فيها اتخاذ قرارات بصيغة لا يخولها الدستور للملك أصلا، من قبيل “إقالة الحكومة الحالية” و”حل الأحزاب السياسية المتورطة في الفساد” وعقد “جلسة وطنية علنية يرأسها الملك لمساءلة الحكومة أمام الشعب”… وبالنظر للتأطير المرفق بهذه اللائحة، الذي يشدّد على عدم نشر هذه المطالب حتى يجري تدقيقها وتعميقها، سأتركها جانبا إلى حين اعتمادها رسميا من قبل الحركة…
عموما، وأخذا بالاعتبار حضور الخلفيّات السياسية والاقتصادية، فإن المحرك الأساسي لهذه الاحتجاجات هو الإحساس المتنامي بانسداد الأفق أمام أزمة خانقة تعكسها الأرقام الرسمية نفسها: معدل البطالة في المغرب بلغ نهاية سنة 2024 نحو 13.3% من مجموع القوى النشيطة، أي ما يعادل 1.63 مليون معطّل. النسبة ترتفع أكثر في المدن لتصل إلى 16.9%، بينما تقفز إلى مستوى صادم وسط الشباب (15-24 سنة) حيث بلغت حوالي 36.7%. وبين خريجي الجامعات، تصل البطالة إلى حوالي 20%، وهو ما يفسر الإحباط المتزايد لدى آلاف الشباب المتعلمين، المتخرّجين منهم أو من هم في طور التخرّج، والذين يجدون أنفسهم في حالة إقصاء من سوق الشغل.
هذه المؤشرات تتزامن مع ضغوط معيشية خانقة، أبرزها ارتفاع الأسعار وتكاليف السكن، فضلاً عن هشاشة الخدمات الأساسية، خصوصاً في الصحة والتعليم. فبالرغم من أن قانون المالية لسنة 2025 خصّص للتعليم نحو 85.6 مليار درهم (أي ما يمثل حوالي 23% من إجمالي النفقات الحكومية)، وللصحة حوالي 32.5 مليار درهم (ما يعادل 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، إلا أن أثر هذه الأرقام يبقى ضعيفاً على حياة المواطن اليومية بحكم التوجّهات السياسية المختلة، التي تنهجها حكومة أخنوش، ولعلّ أبرز دليل على ذلك أن الأسر المغربية ما زالت تتحمل حوالي 38% من كلفة العلاج عبر الدفع المباشر، وهي نسبة تفوق بكثير السقف، الذي توصي به منظمة الصحة العالمية وهو 25%.
هذه المعطيات، التي ظهر أن الجيل الجديد مُلمّ بها بشكل عميق، تُبرز أن المشكلة لا تكمن فقط في حجم الميزانيات المرصودة، بل في طبيعة الإنفاق وتوزيعه، والتي تجعل كل تلك الميزانيات عديمة الأثر، بفعل سوء التدبير والفساد، كما هو الحال مع ملفات المخطط الاستعجالي في التعليم التي لم تُطو بعد، إضافة إلى الفوارق المجالية الصارخة بين الحواضر الكبرى والمناطق المهمشة.
في المحصلة، نكون أمام أوضاع مشتعلة: بطالة متفشية في صفوف الخريجين، غلاء كلفة المعيشة، هشاشة الخدمات العمومية خاصة في الصحة والتعليم، فضلا عن شعور باللاعدالة المجالية بين مناطق المغرب المختلفة. هذه التراكمات تفسر لماذا وَجدت شعارات “GenZ212” صدى سريعا في أوساط شبابية واسعة، كما توضّح لنا لماذا فضّل هذا الجيل حصر لائحة مطالبه في هذه القضايا بالذات، التي يكتوون، هم وعائلاتهم، بنيرانها.
التركيز على هذه المطالب الاجتماعية والاقتصادية، لا يحجب أن الإشكال هنا سياسي بالأساس، فاحتجاجات “جيل Z” لا يُفترض أن تكون حركة مطلبية “عابرة” كما أُريد لحركة 20 فبراير أن تكون، والتي كانت بدورها تعبيرا عن أزمة ثقة عميقة بين الشباب ومؤسسات الوساطة السياسية، وهذا ما ظل الجالس على العرش ينبّه إليه ويحذّر منه في العديد من الخطب والرسائل الملكية، حتى وصل به الأمر إلى إرسال مبعوث ملكي خاص ممثلا في وزير الداخلية ليُفسر ويشرح لـ”قيادات” الأحزاب المغربية أبعاد وخلفيات وجوهر توجيهات الملك للوقوف على تغيير المنظومة الانتخابية التي تُبقي على نفس الوجوه المكرورة الفاسدة مما جعل الأحزاب تتراجع بشكل مهول في القيام بدورها الدستوري التأطيري، وظلت تولي كل اهتماماتها إلى “مالين الشكارة” الذين يلبّون لهثها ولهطتها إلى الأموال والمقاعد والمناصب، فيما تقوم، عن سابق رصد وترصد، بإهمال وتهميش الشباب، الذين يتعدّون ثلث سكان المغرب، أي أزيد من 12 مليون نسمة، نصفهم تقريبا ينتمي إلى شريحة جيل Z، الأمر الذي يكرّس وضعية العزوف الانتخابي، الذي تجاوز 65% في انتخابات 2021، بينما لم يشارك غالبية جيل Z في التصويت، ما يؤشر على فجوة عميقة مع السياسة التقليدية، التي لم تنتبه إلى تطورات وتحوّلات الفضاء الرقمي، فالمغرب يضم أكثر من 26 مليون مستخدم نشيط للإنترنت، وحوالي 18 مليون حساب على فايسبوك، و11 مليون على تيك توك، ما يجعل هذا الجيل قادرا على تحويل الغضب الافتراضي إلى ضغط واقعي.
إن ما يريده هذا الجيل ليس فقط مدارس مجهزة أو مستشفيات مؤهلة، بل أيضا اعترافا بوجوده كفاعل اجتماعي وسياسي له الحق في التأثير على القرار العمومي. وستكون الدولة أمام منعطف: إذا تجاهلت هذه الرسالة، فإن الأزمة مرشحة للتفاقم. أما إذا أحسنت قراءتها، فقد تتحول هذه الاحتجاجات من تهديد للاستقرار إلى فرصة لإعادة بناء جسور الثقة بين الشباب والدولة، عبر حوار شفاف وإصلاحات حقيقية تُعيد الأمل في المستقبل، وتدفع جميع الفاعلين المعنيين إلى بذل جهود مضاعفة لإبداع حلول مبتكرة تمكّن من بعث رسالة واضحة إلى هذا الجيل أن الدولة والمجتمع معا استمعا جيدا لصوته وبلورا مقترحات عملية لتوفير سبل إشراكه في صنع القرار السياسي، وبالخصوص في هذه الظرفية، التي تتهيّأ البلاد للانتخابات.
الهيئات السياسية قدّمت مقترحاتها، تنفيذا لأوامر رئيس الدولة، التي تكلّف وزير الداخلية بتبليغها إلى قادة التنظيمات الحزبية، رغم أن الحاضر الغائب في جوهر هذه العملية هما فاعلان أساسيان: الأول مُستجد، ويتمثل في شباب “جيل Z” الذي فضّل إبعاد نفسه ووجوه من الانخراط في لائحة مطالبه السياسية، والثاني تقليدي، ويتمثّل في “الوجود الطبيعي” للداخلية في كل استحقاق انتخابي، ورغم ذلك، فقد تكلّفت الوزارة باستقبال مقترحات الأحزاب، لكن لا أحد سأل وزارة عبد الوافي لفتيت عن مقترحاتها هيّ لترجمة توجيهات الملك بشأن الانتخابات، وبالخصوص آليات النزاهة والحد من كل المظاهر والممارسات الفاسدة، بتوسيع صلاحيات القضاء، وتقوية آليات الرقابة والفصل بين السلط، ومنح الشباب والمجتمع المدني أدوات مؤسساتية للمشاركة، والبحث عن مداخل للحيلولة دون تسلّل الفاسدين إلى المؤسسات الدستورية، ودون عودة نفس الوجود الخالدة بمجلسي البرلمان، من خلال إقرار تدابير أخلاقية يوقع عليها أمناء الأحزاب تمنع ترشّح هؤلاء للانتخابات المقبلة… فضلا عن الإشكالية المستجدة، وهي كيف يمكن إدماج “جيل Z” في القوانين الانتخابية المقبلة كرهان استراتيجي للمغرب.
آليات لإدماج “جيل Z” في مقترحات قوانين الانتخابات
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومع ما انتهى إليه الحراك الاجتماعي الجديد، وما تخلفت عن فعله الأحزاب السياسية بعدما حققت حركة 20 فبراير ذلك الإنجاز الكبير المتمثل في مراجعة حقيقية لدستور المملكة، يبرز سؤال محوري في النقاش العمومي المغربي: كيف “مُنع” الحزب الإسلامي من تنزيل مضامين هذا الدستور، وكيف تعمدت أحزاب “التغول” الحكومي الحالي من سن قوانين تعلو على مقتضيات هذا الدستور المغربي الذي صوت عليه المغاربة.
مسار الإصلاحات السياسية الحالية، خصوصًا في ما يتعلق بالقوانين الانتخابية، مسارٌ من المفروض أن يجد الحلول القانونية لدمج “جيل Z”، ومعه بالأساس جيل حركة 20 فبراير الذي مازال يراوح مكانه لغاية اليوم.
هذان الجيلان باتا اليوم الفئة الأكثر تأثيرًا على مستقبل العملية الديمقراطية. غير أن نسب المشاركة السياسية للشباب ظلت متواضعة، حيث لم تتجاوز نسبة التصويت في صفوف الفئة العمرية ما بين 18 و24 سنة حاجز 20% في انتخابات 2021، فما بالك الجيل الذي قبله، ما يعكس فجوة واضحة بين المؤسسات السياسية والجيل الجديد. كما أن هذه المعطيات تطرح إشكالية أساسية: كيف يمكن للقوانين الانتخابية المقبلة أن تستوعب هؤلاء الشباب كفاعل سياسي حقيقي بدل أن يبقى في موقع العزوف أو الاحتجاج غير المؤطر، وتتعقّد المعضلة أكثر بوجود نسبة غالبة من القاصرين ضمن الشباب المحتجين، قدّرتها وزارة الداخلية بما يقارب 70%، فيما بعض المجموعات المحتجة بلغت فيها نسبة الأطفال 100%.
وأخذا بالاعتبار هذا المعطى، وكمحاولة لردم الفجوة بين الأحزاب وهؤلاء الشباب، يمكن أن أقترح الآليات التالية:
– مراجعة سن التصويت: فتح النقاش حول تخفيض سن الأهلية الانتخابية إلى 16 سنة، على غرار النمسا وألمانيا مثلا، وبما يسمح بتوسيع قاعدة الناخبين الشباب.
– كوطا شبابية: إدراج حصة إلزامية للشباب دون 30سنة داخل اللوائح الوطنية والجهوية، على أن تصل النسبة إلى 20%، ضمانًا لتمثيلية فعلية داخل البرلمان، وكذا المجالس المنتخبة، مع تخصيص مقاعد جهوية للشباب القروي لتجاوز مركزية المدن الكبرى.
– التصويت الرقمي: اعتماد آليات حديثة للتسجيل والتصويت الإلكتروني الآمن، انسجامًا مع الطابع الرقمي لـ”جيل Z”، الذي يعيش يوميًا في الفضاء الافتراضي.
– دعم مرشحي الشباب: تخصيص صندوق مالي مستقل لدعم المرشحين الشباب، أسوة بالدعم العمومي للأحزاب، لتشجيعهم على خوض غمار المنافسة الانتخابية.
– إلزامية إدماج قضايا الشباب في البرامج: النص قانونيًا على ضرورة تخصيص برامج انتخابية واضحة تتعلق بالتشغيل والتعليم والرقمنة والبيئة، مع آلية لمتابعة تنفيذها.
– إشراك المجتمع المدني الشبابي: تمكين منظمات الشباب والجمعيات الطلابية من المشاركة في صياغة النصوص الانتخابية عبر جلسات استماع برلمانية.
التغيير ممكن إذا توفّرت الإرادة السياسية
المقترحات أعلاه تهدف، بالأساس، من جهة: إلى تجاوز العديد من الظواهر السياسية المختلّة، من قبيل ضعف الثقة في الأحزاب، ومحدودية فرص ترشّحهم، وغياب خطاب سياسي يتجاوب مع قضاياهم… ومن جهة ثانية: إلى الاعتراف الإيجابي بالتحدي الديمغرافي والسياسي الراهن، إذ أن ارتفاع نسبة الشباب يجعلهم رهانًا استراتيجيًا لأي إصلاح سياسي. وفي هذا الصدد، وبرؤية مستقبلية، يمكن التشديد على توفير التربية المدنية والانتخابية لكل الأطفال والشباب المغاربة، وفي مقدمة السّبل لتحقيق ذلك، إقرار إدراج التربية الانتخابية في المقررات الدراسية، مع تنظيم محاكاة انتخابية في المؤسسات التعليمية لتدريب الشباب على الممارسة الديمقراطية، كما هو جاري به العمل في العديد من التجارب الدولية، التي يمكن ملاحظتها مثلا في النمسا وألمانيا وإستونيا، والتي أظهرت إمكانية إدماج الشباب عبر التصويت المبكر والآليات الرقمية، الأمر الذي يمكن بلورته من خلال صياغة مقاربة تشاركية جديدة تجعل من الشباب جزءًا من صناعة القرار وفاعلا سياسيا مباشرا داخل المؤسسات. والشرط الأساس لكل هذا سيبقى مرهونا بمدى توفّر إرادة سياسية حقيقية لمباشرة جيل جديد من الإصلاحات الديمقراطية.
يتبع..

الركراكي يوجه الدعوة لأنس باش لمباراتي البحرين والكونغو يومي 9 و14 أكتوبر

سعيد الكحل: جيلz والحاجة إلى الاستثمار في الإنسان

الاستئناف يؤيد سجن مؤرخ جزائري شكك في الثقافة الأمازيغية

مونديال 2026: البيضاء تستضيف أربع مباريات لحساب الجولتين التاسعة و العاشرة

مطالب برلمانية بحضور وزير الصحة لكشف حقيقة دعم المصحات الخاصة

لبنان: فضل شاكر أمام التحقيق العسكري

الاحتجاجات الشبابية بين المشروعية والتوظيف السياسي: دعوة إلى تفعيل المجلس الاستشاري للشباب

عجز السيولة البنكية يرتفع بنسبة 1,61 بالمائة من 25 شتنبر إلى فاتح أكتوبر

ترحيل آخر دفعة من المشاركين في أسطول الصمود المحتجزين

المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يستعد للقاء كوريا الجنوبية

مدريد: انطلاق محاكمة مغربي متهم بقتل كاهن كنيسة بإسبانيا في 2023

درجات الحرارة ترتفع في عدة مناطق من المملكة

محكمة الاستئناف تثبت حكم السجن الصادر بحق الناشطة النسوية ابتسام لشكر

نايف أكرد يتعرض لمحاولة اعتداء في مطار مرسيليا

ترحيل 171 ناشطا إضافيا من أسطول المساعدات لغزة بينهم غريتا تونبرغ

الكاف.. يعلن تحقيق ربح قدره 9.48 مليون دولار

مندوبية السجون تنفي وجود وفيات بسجن آيت ملول

بدء المباحثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بشأن غزة في مصر

منح جائزة نوبل في الطب لـ3 علماء عن “اكتشافاتهم المتعلقة بالتحمل المناعي المحيطي”

وزارة الصحة تحيل ملف وفيات مستشفى أكادير على القضاء وتوقف المعنيين مؤقتاً

عن ميلاد مبادرة GenZ212..أي رياح تهبُّ اليوم في فضائنا العمومي؟

المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة يُجري حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام

ترامب: “أعتقد أن لدينا اتفاقا” بشأن غزة

سعيد الكحل.. في الحاجة إلى نموذج سياسي جديد

بلاغ: توقيف شخص يقوم بنشر صور وفيديوهات الاحتجاجات

النيابة العامة: متابعة 193 شخصاً على خلفية أحداث العنف والتخريب الأخيرة

جيل زيد 212: بين أولويات الشباب وأجندة الاحتجاج الجامعة

مبادرة AtlasMouv تعلن عن انطلاق الحملة الترويجية للكان 2025

الدفاع الحسني الجديدي ينهزم أمام ضيفه الرجاء الرياضي (0-2)

أشرف حكيمي: أعيش أزمة لا أتمناها لأحد

سعيد الكحل: متى نقطع مع مستشفيات الموت والإهمال؟

محامو ناشطين فرنسيين على متن أسطول الصمود يناشدون باريس حمايتهم

من الدولة الأمنية إلى الدولة القوية: لحظة الانعطاف نحو جيل جديد من الإصلاحات العميقة

طائرة تركية تحلق فوق أسطول الصمود لليوم الثاني على التوالي

ترحيل 171 ناشطا إضافيا من أسطول المساعدات لغزة بينهم غريتا تونبرغ

من نيويورك.. رئيس كولومبيا يفتح باب التطوع للقتال من أجل فلسطين

أزمة الوساطة السياسية بالمغرب.. حين تفرض احتجاجات “جيل Z” قواعد اللعبة الانتخابية

الجامعة بين الجمود والاحتجاج: هل ينخرط المتعلمون في نقد التعليم بدل تكرار أعطابه؟

المنتخب الوطني لاقل من 20 سنة يواصل استعداداته لكاس العالم

توقيف 3 حكام بعد الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية

الخبير جمال العلمي يكشف أسرار ” صومعة المكانة” La Tour de l’Horloge

“الدوري الأول للراحلة حليمة مرجان”..الرياضة في خدمة العمل الخيري

الرباط تكرّم الراحل يونس رودياس أحد رموز كرة السلة بنادي الفتح الرياضي

الوداد الرياضي يحتفل بذكراه الـ88.. ليلة وفاء وتكريم لأساطير الأحمر

المغرب يدخل عصر العلاج الثوري لسرطان البروستاتا بتقنية HIFU

في حفل تأبيني مؤثر.. سبور بلازا يكرم روح الراحل كمال لشتاف

نادي “النور اولاد صالح” ينظم الدوري السنوي للكرة الحديدية

تفاصيل مؤامرة الجنرال أوفقير على رفاقه في الجيش وعلى الحسن الثاني

محمد لومة يحكي عن أخطر جرائم أوفقير في حق الوطن والشعب

للمرة الثانية الرباط تحتضن التجمع التدريبي الافريقي BAL في كرة السلة

هكذا اقتطعت الجزائر أجزاء من التراب المغربي و التونسي بدعم من فرنسا ( فيديو)

بالفيديو..تفاصيل محاولة اغتيال الحسن الثاني سنة 1972

1981: مقترح “الاستفتاء” حول الصحراء..عندما قال عبد الرحيم بوعبيد “لا” للحسن الثاني

محمد لومة يكشف مراحل الصراع بين الحسن الثاني و عبد الرحيم بوعبيد (الجزء الأول)

تفاصيل تحكى لأول مرة عن اغتيال الشهيد عمر بن حلون (الحلقة الثانية)

و شهد شاهد من أهلها..حقائق تكشف لأول مرة عن اغتيال الشهيد عمر بن جلون

حورية أجدور..صوت مجدد صاعد في سماء الأغنية الأمازيغية “فيديو “

تهلاو فالصحيحة :الدكتور عماد ..هذه هي الفوائد الصحية للجبن” فيديو”

“ذاكرة ليست للنسيان” 4/4 بسبب نزعته الانتقامية، ادريس البصري يحتفظ ب 12 تلميذا داخل معتقل ” درب مولاي الشريف” لمدة ثلاث سنوات دون محاكمة.

تعرفو على فوائد الخل الطبيعي على صحة الجسم والبشرة مع الدكتور عماد ميزاب
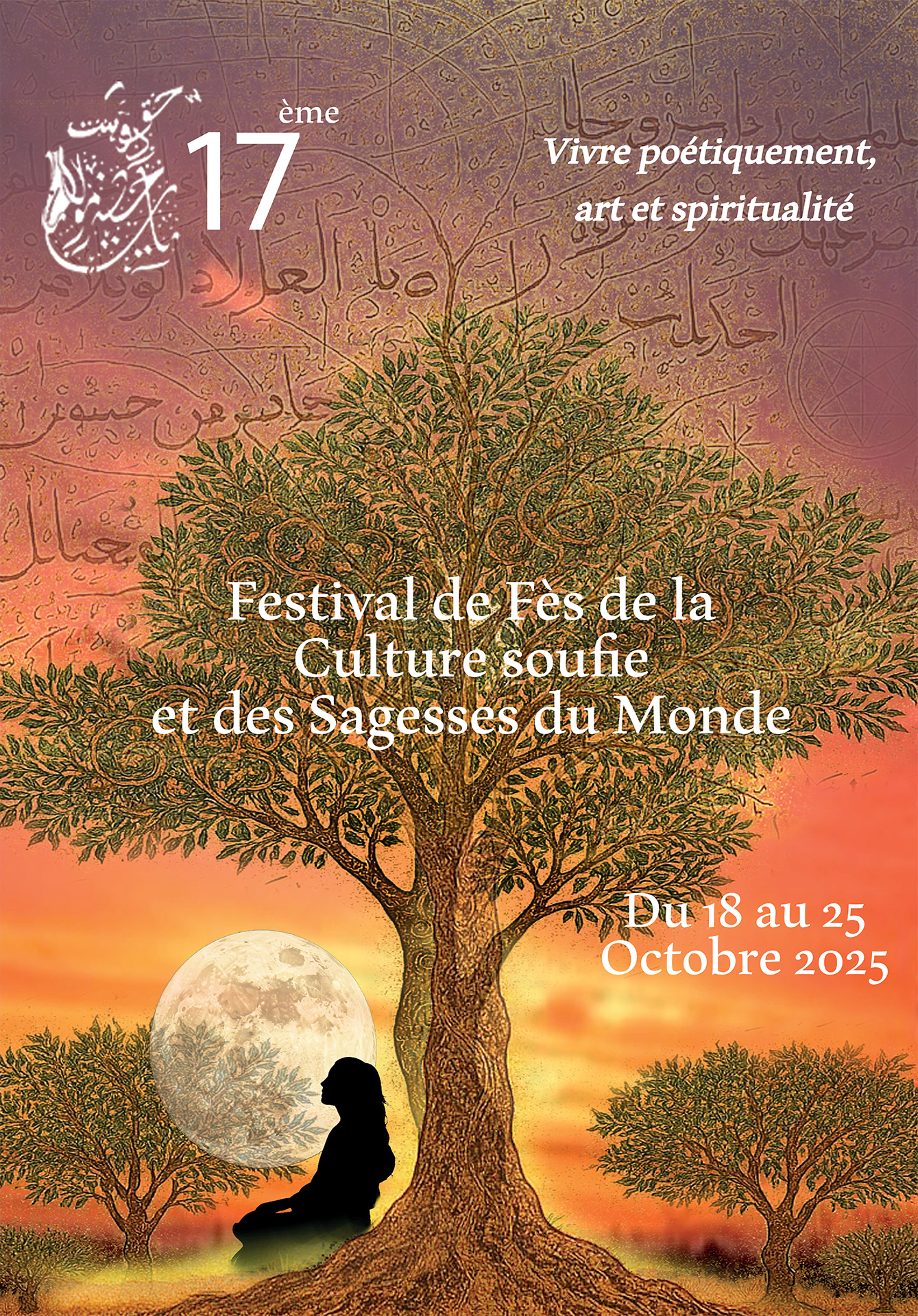
الاكثر مشاهدة
-

 مجتمع منذ 6 أيام
مجتمع منذ 6 أيامالنيابة العامة: متابعة 193 شخصاً على خلفية أحداث العنف والتخريب الأخيرة
-

 على مسؤوليتي منذ 5 أيام
على مسؤوليتي منذ 5 أياممن الدولة الأمنية إلى الدولة القوية: لحظة الانعطاف نحو جيل جديد من الإصلاحات العميقة
-

 دولي منذ يوم واحد
دولي منذ يوم واحدترحيل 171 ناشطا إضافيا من أسطول المساعدات لغزة بينهم غريتا تونبرغ
-
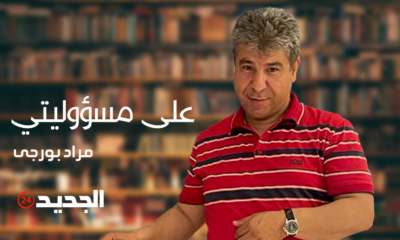
 على مسؤوليتي منذ يومين
على مسؤوليتي منذ يومينأزمة الوساطة السياسية بالمغرب.. حين تفرض احتجاجات “جيل Z” قواعد اللعبة الانتخابية
-

 على مسؤوليتي منذ 3 أيام
على مسؤوليتي منذ 3 أيامالجامعة بين الجمود والاحتجاج: هل ينخرط المتعلمون في نقد التعليم بدل تكرار أعطابه؟
-

 رياضة منذ 5 أيام
رياضة منذ 5 أيامتوقيف 3 حكام بعد الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية
-

 واجهة منذ 3 أيام
واجهة منذ 3 أياموصول 137 من المشاركين في أسطول الصمود إلى تركيا
-
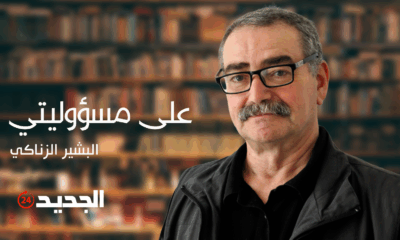
 على مسؤوليتي منذ 3 أيام
على مسؤوليتي منذ 3 أيامالبشير الزناكي يكتب عن GENZ و رهاناته الصعبة
