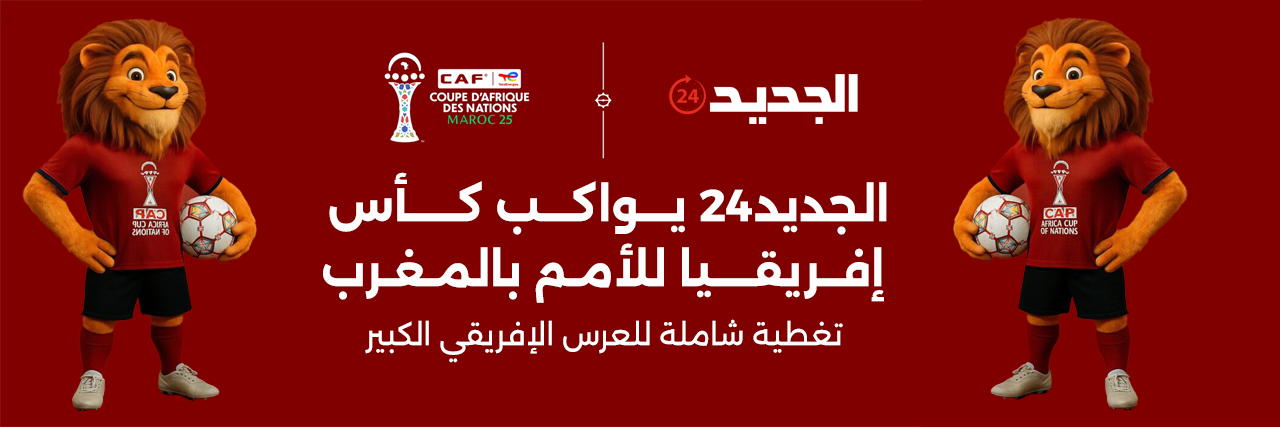على مسؤوليتي
الوكلاء عن الدولة بين التبرير الشعبوي والتقنوقراطي
نشرت
منذ 7 أشهرفي
بواسطة
مصطفى المنوزي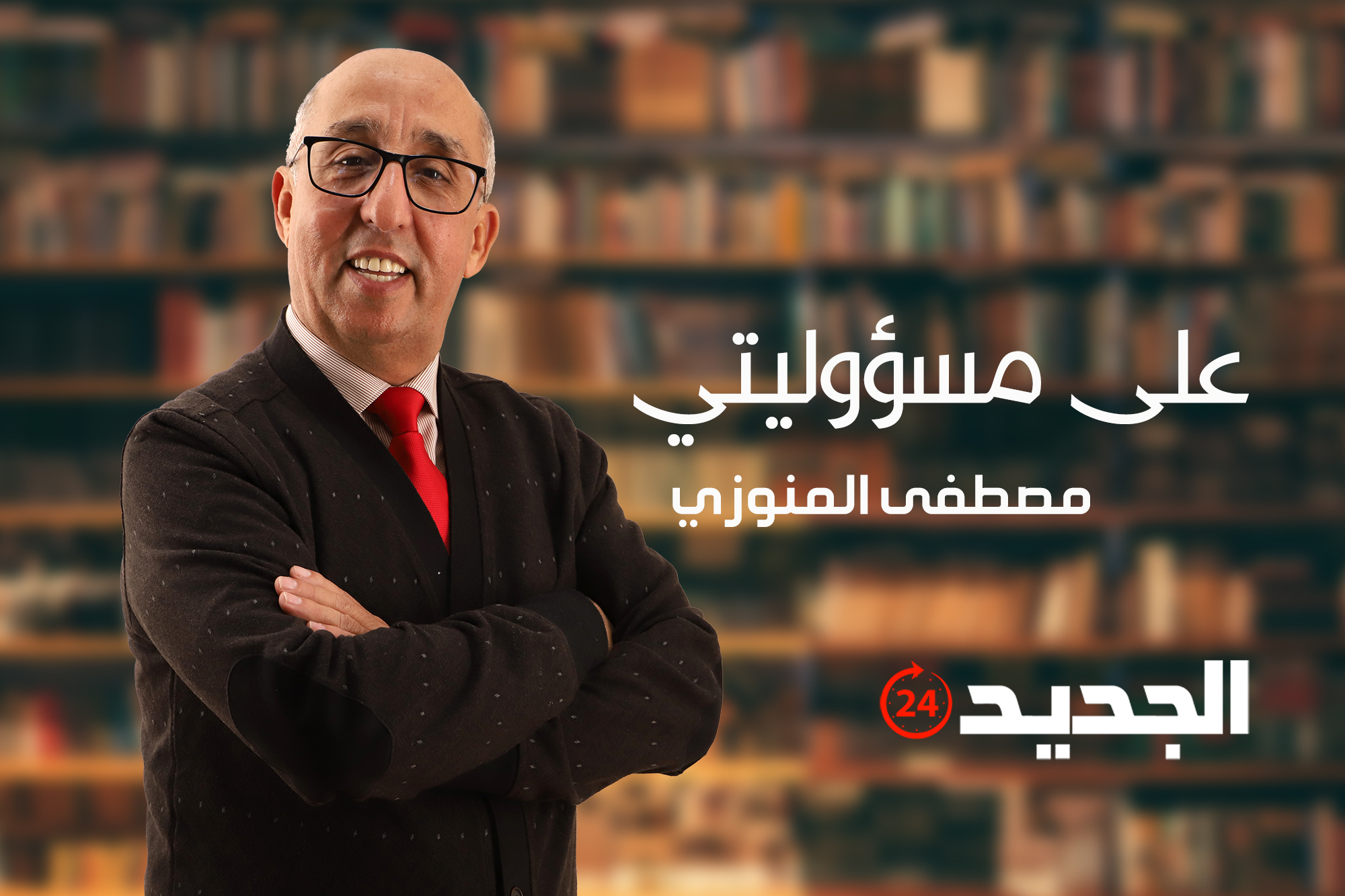
*(قراءة ميتولوجية في مشهدية الدولة المغربية )
سنحاول من خلال هذا المقال، أن نسلط الضوء على بنية العلاقات والصراعات في المتون الميتولوجية، التي غالبًا ما تتمحور حول صراع الأب والابن (مثل كرونوس وزيوس في الميثولوجيا الإغريقية) أو الأخ والأخ (مثل قابيل وهابيل في الميثولوجيا الإبراهيمية، أو سِت وأوزير في المصرية القديمة).
لكن صراع الإبن والأخ أو الأخ مع ابن أخيه – أي علاقات أكثر تعقيدًا بين الأجيال المتقاطعة – أقل حضورًا في الميثولوجيا الكبرى، غير أنه ليس غائبًا تمامًا، وهناك بعض الأمثلة وإن كانت نادرة أو مغفلة:
1. في الميثولوجيا الكنعانية: هناك بعض الروايات المتفرعة التي يظهر فيها تعارض بين العم (الأخ الأكبر) وابن أخيه في صراعات وراثية حول السيادة أو السماء، مثل ما يُروى عن إيل وبعل.
2. في التوراة (العهد القديم): هناك تعقيدات في نسب الأسرة الإبراهيمية، حيث نجد توترات بين يعقوب وعيسو (أخوين)، ولكن أيضًا بين أبناء العم أو الأخوة غير الأشقاء، مثل إسحاق وإسماعيل من زاوية توتر السلالة.
3. في الملاحم الإغريقية: يمكن رصد توتر بين أبناء الإخوة أو أحفاد، كما في ملحمة “الأوديسة”، حينما يتصارع تيليماخوس (ابن أوديسيوس) مع أبناء المتنافسين على عرش أبيه، الذين ينتمون أحيانًا إلى فروع عائلية قريبة.
4. في بعض الحكايات الأسطورية أو الشعبية الهندية والجرمانية: تظهر نزاعات بين أبناء الأخوة، كجزء من نزاع قبلي على الإرث أو الدم.
لكن سبب ندرة هذا النوع من الصراع راجع إلى أن الميتولوجيا تميل إلى تجسيد الصراعات الكبرى في شكل ثنائيات واضحة:
الأب/الابن: صراع السلطة والوراثة.
الأخ/الأخ: صراع المساواة والغيرة.
بينما صراع “الإبن/الأخ” قد يُعتبر “هجينًا” في منطق السلطة الرمزية، لأنه يجمع بين التراتبية والقرابة الجانبية، مما يُضعف رمزيته كنموذج سردي واضح.
إن الغاية من هذا التمهيد التاريخي الإسترجاعي، فتح أفق تأويلي مهم يروم إبراز أسباب الصراع بين “الإبن والأخ” بالنيابة أو بالوكالة، وهو شكل ميتولوجي غير مباشر، غالبًا ما يُخفي علاقات السلطة والرغبة والانتقام تحت ستار من التراتبية الرمزية. في هذا السياق، يمكن أن نجد عدة أمثلة في المتون الميثولوجية والأدبية، خاصة إذا قرأناها بمنهج تفكيكي أو سيميولوجي.
وهذه بعض الملاحظات والأمثلة الدالة :
1. صراع بالوكالة بين الإبن وعمّه (أخ الأب)
* قصة هاملت (المسرح الإليزابيثي): هاملت يصارع عمّه . *كلوديوس(الذي قتل والده وتزوج أمه)، لكن الصراع هنا ليس فقط انتقاميًا مباشرًا، بل يمثل حربًا بالوكالة عن الأب المقتول. هنا يتجلى صراع الإبن مع “الأخ” (عمّه) في سياق عائلي وسلطوي مزدوج.
2. صراع مركزي في الملحمة الحسينية :
* حسين بن علي ويزيد بن معاوية: يزيد هو ابن معاوية، الخصم التاريخي لعلي بن أبي طالب، وهكذا فإن معركة كربلاء يمكن قراءتها أيضًا كامتداد لصراع “الإبن (الحسين) مع الأخ (معاوية) بالنيابة”، حيث يزيد يمثل امتدادًا لمشروع الأب، بينما الحسين يحمل عبء مشروع الأب (علي). إنها إذن مواجهة بين ورثة الصراع المؤجل.
3. في الميثولوجيا الإغريقية – نموذج أوريستيس
أوريستيس ينتقم من أمه كليتمنسترا وعشيقها إيجيسثوس، الذي قتل أباه أجاممنون. إيجيسثوس كان من العائلة (ابن عم أو أخ غير شقيق حسب الروايات). وهنا نرى أن أوريستيس يصارع “بديلاً عن أبيه”، وبالوكالة عن شرف العائلة.
4. في بعض الروايات الأمازيغية والأساطير الإفريقية
تُروى قصص فيها “ابن أحد الأخوة” يتولى الثأر أو الدفاع عن جدّه أو عمّه، أو يدخل في صراع مع أبناء العمّ – في شكل صراع جيلين لكن بالنيابة عن جيل سابق. في هذه الحكايات، البُعد الاجتماعي والرمزي للصراع يكون حاسمًا، ويظهر كيف يُستخدم الجيل الجديد لتصفية حسابات الجيل السابق.
5. في الرواية الإسلامية العامة: قصة يوسف
الإخوة يرمون يوسف في البئر، وهو ليس صراعًا تقليديًا بين إخوة متساوين، بل هناك تواطؤ بالنيابة: يعقوب يمثل رمزًا للنبوءة والاصطفاء، والإخوة يَغارون من تمثيل يوسف لهذه المكانة. الصراع هنا ليس بين يوسف وإخوته كأفراد، بل بينهم كممثلي تيارين داخل الأسرة: تيار الاصطفاء الإلهي (يوسف) وتيار التهميش .
في سرديات الميثولوجيا، نادراً ما نعثر على صراع مباشر بين “الأخ” و”الابن” في حضرة الأب المؤسس أو السيد المطلق. غير أن هذه المفارقة المفقودة في الخيال الأسطوري، تطفو على سطح الواقع السياسي المغربي في صيغتها الرمزية، حيث يتمثل الصراع بين وكيلين للسلطة، خرجا من رحم الوظيفة العمومية، وبلغا ذروة الدولة، ليخوضا باسمها صراعاً بالوكالة: صراع تبرير لا صراع مشروع.
يمثل “الابن”، من حيث الخطاب، النمط الشعبوي المحافظ، الذي يستمد شرعيته من القرب من وجدان الجماهير، ومن تطويع خطاب الدين لتبرير اختلالات الحكم بدعوى وجود “التحكم”، دون أن يُحدث قطائع بنيوية. أما “الأخ “، فهو التجلي المعكوس لذلك: تكنوقراطي نيوليبرالي، يوظف الأرقام والوعود التقنية، لتبرير الاختلالات ذاتها، متوسلاً صمت النخبة، بدل ضجيج الجماهير.
كلاهما، في الجوهر، ليس إلا مُجَمِّلًا لوجه الدولة، من خلال أسلوبه الخاص: أحدهما يتحدث بلسان الغضب المُروّض، والآخر بلسان الهدوء المُصطنع. وبذلك يتحولان إلى ما يشبه “أبولّو وديونيسوس” في الميثولوجيا اليونانية: آلهة لا تتصارع على السلطة، بل على كيفية تمثيلها وإعادة إنتاج سحرها الرمزي.
ولأنهما لا يُشَكِّلان تهديداً حقيقياً لعرش السلطة، بل يضمنان استقرارها من خلال تباين صوري، فإن الدولة تجد في هذا الصراع الوهمي، ما يكفي لإعادة ترميم شرعيتها دون الحاجة إلى إصلاح حقيقي. إنها المفارقة: حين يتنازع الوكلاء، تستريح السلطة الأصلية.
هكذا يصبح الصراع بين الأخ والابن صراعًا على من يُقنِع أكثر، لا على من يُصلِح فعليًا. فكل منهما يُبيض الأعطاب المخزنية بطريقته: أحدهما بماء البلاغة، والآخر بمساحيق التنمية.
إن قراءة هذا الصراع بمنظور ميتولوجي يسمح لنا بفهم أن المغرب ليس أمام تعددية سياسية حقيقية، بل أمام تعدد في التماثيل الرمزية لوظيفة واحدة: وظيفة “تسويق الدولة” لا “تفكيكها أو مساءلتها”.
وبينما ينتظر الناس صراعًا يفضي إلى تغيير، يجدون أنفسهم أمام مسرحية مقدسة، أبطالها من أبناء السلطة، لا من خصومها. فلم يكن الأخ سوى عزيز بنحماد أما الإبن فليس إلا عبده مصارع الثيران ، واللذين قدرا عليهما أن يتصراعا في إنتظار الترخيص لهما بعقد القران محاكاة بسردية النداء والنهضة .
والخلاصة / الرسالة أنه علينا ألا ننخدع بفخ التناوب أو التشخيص الأخلاقي للأشخاص، بل أن نطرح السؤال الحقيقي:
هل ما نراه صراعًا سياسيًا هو في الحقيقة مجرد تقاطع سردي لوظيفتي التجميل السياسي؟.
وإذا كان الصراع لا يتجاوز حدود تمثيل السلطة، فهل يمكن أن يُنتج بدائل، أم أنه يُعيد إنتاج نفس النظام بلغات مختلفة؟.
*مصطفى المنوزي
على مسؤوليتي
سعيد الكحل: الفقيه الريسوني يعود إلى عادته القديمة
نشرت
منذ 6 أيامفي
ديسمبر 8, 2025بواسطة
سعيد لكحل
أصدر الفقيه الريسوني، بتاريخ 29 نونبر 2025، فتوى تحت عنوان “فتوى حول التعامل مع المحتلين والمعتدين”، يحرم فيها كل أشكال التعامل مع إسرائيل ومع الشركات والجهات الداعمة لها.
* التطاول على صلاحيات لجنة الإفتاء.
يصر الفقيه الريسوني على مخالفة إجماع المغاربة وتشبثهم، من جهة، بمرجعيتهم الدينية التي تلزمهم بطاعة ولي الأمر، ومن أخرى بوثيقتهم الدستورية التي تنص في الفصل 41 بأن “الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه. ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا، بشأن المسائل المحالة عليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة”.
والفقيه الريسوني، بفتواه تلك التي تخرق الدستور وتتنكر لمذهب المغاربة وما أجمعوا عليه حفاظا على وحدتهم، يصر على تنصيب نفسه “مفتيا” في شؤون المغاربة الدينية والدنيوية. وليست المرة الأولى التي يتطاول فيها على اختصاصات المجلس العلمي الأعلى، بل سبق له أن فعلها مرات عديدة، حيث كانت أولاها يوم تصدى لمشروع خطة إدماج المرأة في التنمية، متهما واضعيه ومسانديه بمحاربة الدين وهدم ما تبقى من حصونه. إلا أن أخطرها لما طعن في أهلية الملك لإمارة المؤمنين، سنة 2003، فاضطر، ساعتها إلى تقديم استقالته من رئاسة حركة التوحيد والإصلاح. وها هو اليوم يواصل استهدافه لإمارة المؤمنين تنفيذا لمخطط تنظيم الإخوان الدولي الذي كشفت عنه رسالة مرشد التنظيم في مصر، مصطفى مشهور، إلى تنظيمات الإسلام السياسي بالمغرب سنة 1996، ومن أهدافها: ضرب الشرعية الدينية للملك ومنازعته صلاحياتها. لهذا شدد الفقيه الريسوني في فتواه على البعد الديني وذلك بالتحريم القاطع لأي تعامل مع إسرائيل.
* فتوى سياسية وليست دينية.
إن الفقيه الريسوني لم ينصّبه الدستور مفتيا ولا تم تعيينه رئيس لجنة الإفتاء. إنما هو لسان حال تنظيم الإخوان يروج لشعارات فرعه بالمغرب التي ظلت ترددها الجماعات المنتمية إليه على مدى خمس سنوات، واشتد صرخاتها مع “طوفان الأقصى” في محاولة يائسة للضغط على المغرب لقطع كل العلاقات مع إسرائيل. لم يكن هدف الريسوني ومعه إخوانه في التيار نصرة أهل غزة، بل استثمروا في مآسي الفلسطينيين أملا، من جهة، في استرجاع مواقعهم الانتخابية التي خسروها بسبب فقدانهم أصوات الناخبين، ومن أخرى سعيا إلى استهداف شرعية النظام الدينية والسياسية. ذلك أن تنظيمات الإسلام السياسي وفقهائها وعلى رأسهم أحمد الريسوني الذي تولى رئاسة “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” الذي يتشكل من الأعضاء المنتمين لهذا التيار قبل أن يستقيل مضطرا، لم يصدروا بيان إدانة ضد قطر وتركيا اللتين تربطهما علاقات قوية ومتعددة مع إسرائيل. فقد سبق لمحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أن صرح، في لقاء صحفي لقناة “فوكس” الأمريكية أن “دولة قطر منذ التسعينيات، منذ أوسلو كانت أول دولة تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، عندما كان هناك أمل في السلام، وفي عام 1997 وقعنا على البعثات التجارية.. حتى الآن لا تزال لدينا علاقة العمل هذه، لم تتوقف”. كما سبق لمعهد أبحاث الإعلام في الشرق الأوسط (MEMRI) أن سرّب وثائق تثبت تمويل الحكومة القطرية لمسؤولين إسرائيليين ضمن “مشروع رافين”، ومنها وثائق يرجع تاريخها إلى عامي 2012 و2018، حين قدمت قطر منحتين على الأقل، لنتنياهو، الأولى قدرها 15 مليون دولار في عام 2012 والثانية قدرها 50 مليون دولار في عام 2018. نفس الأمر فيما يتعلق بتركيا التي تربطها علاقات قوية بإسرائيل؛ إذ تشير الأرقام إلى أن قيمة صادرات تركيا من الصلب إلى إسرائيل بلغت في مارس 2024 نحو 13 مليوناً و901 ألف و470 دولاراً، مقارنة بـ153 ألفاً و400 دولار فقط في الشهر نفسه من عام 2023، أي بزياد مهمة بنسبة 8962.2%. أما قيمة صادرات الصلب خلال الربع الأول من 2024(يناير–مارس)، فقد بلغت 41 مليوناً و421 ألفاً و420 دولاراً، في مقابل 177 ألفاً و560 دولاراً في الفترة نفسها من عام 2023، أي بزيادة نسبتها 23228.1%. أما حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا فقد بلغ 7 ملايير دولار. رغم حجم التبادل التجاري لم يهاجم الريسوني أو تنظيمات الإسلام السياسي تركيا؛ بل برروا علاقاتها مع إسرائيل ودافعوا عنها كما هو حال حركة حماس التي قالت، مباركة تلك العلاقات، إنها “تتطلع إلى مواصلة تركيا لدورها في دعم القضية الفلسطينية وإنهاء الحصار بشكل كامل”. لكن حين تعلق الأمر بالمغرب سارعت الحركة إلى الإدانة معتبرة تطبيع العلاقات مع إسرائيل “يعد خطيئة وسلوكا مضرا بمصالح الأمة وأمنها ويمثل خطرا على القضية الفلسطينية وطعنة في ظهر شعبنا وأمتنا”.
* تنظيم الإخوان لا يؤمن بالأوطان.
ليس مستغرَبا أن يتجاهل الريسوني ومعه إسلاميو المغرب ظروف المغرب وقضيته الوطنية الأولى التي تستنزف مقدراته على مدى نصف قرن؛ فهم لا يؤمنون بالوطن وعلى استعداد للتضحية بمصالحه العليا من أجل أوهامهم الإيديولوجية العابرة للحدود. وهذا ما يفسر فتح أسواق المغرب على مصراعيها أمام المنتوجات التركية رغم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها، فضلا عن الاستغلال الفظيع لقضية غزة لتجييش المواطنين وحشدهم في مظاهرات واحتجاجات لا تنتهي من أجل الضغط على النظام لقطع العلاقات مع إسرائيل. ذلك أن الإسلاميين لا يقدّرون المكاسب الدبلوماسية والعسكرية للدعم الأمريكي والإسرائيلي للمغرب والذي أثمر قرار مجلس الأمن 2797 المعترف بالسيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية. كما لم يكترثوا للتهديدات المتزايدة التي يشكلها النظام الجزائري على أمن المغرب وحدة أراضيه. وهذا الذي على الريسوني وإخوانه الوعي به واستحضاره حين الحديث عن “التطبيع” ومزاياه الدبلوماسية (الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء) والعسكرية (تزويد المغرب بأحدث الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية الرادعة لأي عدوان وبتقنيات صناعتها (نموذج صناعة الدرونات الانتحاريةSPX). فمن حق المغرب أن يستفيد من الدعم العسكري الإسرائيلي مثلما استفادت منه تركيا في تطوير جيشها.
إن فتوى الريسوني بمقاطعة كل الشركات التي يضعها تنظيم الإخوان ضمن خانة “الداعمة لإسرائيل”، لا يريد بها دعم غزة بقدر ما يسعى إلى الإضرار مباشرة بالاقتصاد الوطني وبالوضع الاجتماعي للمغاربة الذي سيترتب عن إغلاق الشركات والمؤسسات الإنتاجية والخدماتية وتسريح عشرات الآلاف من العمال وحرمان خزينة الدولة من عائداتها الضريبة. إنهم يريدون خنق النظام بتأزيم الأوضاع الاجتماعية وتجفيف موارده المالية؛ وتلك إستراتيجية تعتمدها كل تنظيمات الإسلام السياسي.
إن المغرب ليس بحاجة إلى فتاوى الريسوني وأمثاله لتطوير قدراته وبناء علاقاته الدولية. والدعم المغربي الدائم والمبدئي للفلسطينيين لا يتوقف على فتوى ولا يتأثر بمواقف التنظيمات الإخوانية. وعلى سماسرة وتجار القضية الفلسطينية أن يعلموا أن المغرب هو الدولة الوحيدة التي تتحمل مسؤوليتها المالية الكاملة في تمويل بيت مال القدس. وكان حريا بالريسوني أن يتعظ مما جرّته عليه نزواته الفقهية، إذ لا يكاد يرأس هيئة حتى يُطرد منها بسبب تنطعه والإفتاء فيما لا يعنيه ولا يدخل ضمن المجال الفقهي.
* شطحات الفقيه الريسوني.
إن المتتبع لخرجات وفتاوى الريسوني سيدرك تناقضاته/شطحاته التي لا يحكمها مبدأ ثابت. فهو نفسه لم ينضبط لفتواه بتحريم أي تعامل أو “افتاق سلام” مع إسرائيل؛ إذ سبق له أن وافق، سنة 2006، عبر قناة الجزيرة على موقف أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس، بجواز توقيع حركته على هدنة مع إسرائيل. بل ذهب الريسوني أبعد من هذا لما أفتى بإمكان حماس أن تسمي اتفاق الهدنة مع إسرائيل بأنها “اتفاقية سلام” مؤقتة. وفي غشت 2019، نشر فتوى يجيز فيها للمسلمين غير الفلسطينيين زيارة القدس والمسجد الأقصى، مع العلم أنه سبق أن أخبر الصحفي والكاتب الفلسطيني، منير شفيق، أنه “يفضل قطع رأسه على أن يطلب تأشيرة من سفارة صهيونية”.
شطحات الفقيه الريسوني لم تقتصر على العلاقة مع إسرائيل، بل شملت فتاواه قضايا أخرى منها ولاية المرأة على نفسها في الزواج؛ إذ شدد في تحريمها عبر بيانه، سنة 2000، حول مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية، ثم غيّر رأيه، في حوار صحفي، بعد ستة أشهر فقط. وحين أعلن جلالة الملك عن مضمون التعديلات التي همت مدونة الأحوال الشخصية أمام البرلمان سنة 2003، برر الريسوني موافقته على التعديلات بأن “اختيار الحاكم يرفع الخلاف”. لكنه اليوم يقرر مخالفة هذه القاعدة الفقهية والخروج عما أفتى به جمهور الفقهاء بوجوب طاعة ولي الأمر إرضاء لنزعته الأيديولوجية ووفاء لتنظيم الإخوان.
على مسؤوليتي
نحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية
نشرت
منذ أسبوعينفي
ديسمبر 3, 2025بواسطة
الجديد TV
* مقدمة عامة
يشكل المسار الديمقراطي في المغرب ركيزة أساسية لبناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وضمان التداول السلمي على السلطة. وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات في هذا السياق الإصلاحي الذي يهدف إلى تحصين العملية الانتخابية من كل أشكال التلاعب، وضمان النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.
غير أن هذه التعديلات أثارت معارضة واضحة من طرف بعض مكونات الإسلام السياسي، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، في سياق إقليمي ودولي متوتر، يتسم بتصاعد المخاطر الإرهابية، وبالقرارات الدولية المتتالية التي صنفت تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية، كما هو الشأن في مصر، ومع ما راج عن قرار مماثل من الإدارة الأمريكية.
وفي هذا الإطار، نرى أن هذه المستجدات تفرض إعادة طرح سؤال:
هل يمكن السماح لقوى توظف الدين في السياسة، وتنتج خطاب الكراهية والتحريض، بالاستمرار في التنافس الانتخابي دون ضوابط صارمة؟.
ومن هنا تبرز ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب يمنع:
استغلال الدين في الحملات الانتخابية؛
استعمال الشعارات والرموز الدينية لأغراض سياسية؛
توظيف خطاب التكفير والكراهية والتحريض.
مع ترتيب جزاء المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال بهذا الالتزام.
التعديلات الأخيرة على قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وسياقها السياسي
جاءت التعديلات التي صادق عليها البرلمان المغربي على قانون الأحزاب السياسية والقوانين الانتخابية في إطار:
تعزيز النزاهة الانتخابية؛
محاربة توظيف المال والدين؛
عقلنة المشهد الحزبي؛
الحد من الشعبوية الدينية والسياسية.
وقد ركز المشرّع بشكل خاص على:
ضبط تمويل الحملات؛
منع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية؛
تشديد المراقبة على الخطاب الانتخابي؛
توسيع صلاحيات القضاء في الزجر الانتخابي.
غير أن موقف حزب العدالة والتنمية من هذه التعديلات اتسم بالرفض والتشكيك، واعتبرها موجهة ضده، وهو موقف يكشف أن جوهر الاعتراض لا يتعلق فقط بالإجراءات التقنية، بل بمحدودية هامش توظيف الدين انتخابياً، الذي شكّل لسنوات رأس ماله الرمزي الأساسي.
السياق الدولي وتصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية
تشكل القرارات الدولية المتعلقة بتصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية مؤشرا بالغ الخطورة على التحولات التي يعرفها فهم العلاقة بين الدين والسياسة والأمن القومي.
فقد سبق لمصر أن صنفت التنظيم إرهابياً بعد ثبوت:
تورطه في العنف المسلح؛
توفير الغطاء الأيديولوجي للجماعات المتطرفة؛
دعمه لتنظيمات إرهابية عابرة للحدود.
كما تؤكد تقارير وخبراء أمنيون أن:
التنظيم لا يشترط مباشرة تنفيذ العمليات الإرهابية حتى يُصنف؛
يكفي تقديم الدعم المالي أو اللوجستي أو الأيديولوجي؛
الخطاب التعبوي الديني يشكل رافعة أساسية للتطرف.
وتشير المعطيات إلى:
وجود شبكات تمويل عابرة للحدود؛
ارتباطات تنظيمية بين الأجنحة السياسية والدعوية والعسكرية؛
استغلال الحريات الديمقراطية كغطاء للاختراق الأيديولوجي.
وهذا الوضع يطرح بإلحاح سؤال مسؤولية الدول في تحصين أنظمتها السياسية من الاختراق الأيديولوجي المتطرف الذي يبدأ بخطاب ديني انتخابي وينتهي بعنف منظم.
الوضع الأمني بالمغرب واستمرار التهديد الإرهابي
رغم النجاحات الكبيرة للأجهزة الأمنية المغربية في تفكيك الخلايا الإرهابية، فإن الخطر لم يزَل.
وآخر العمليات الاستباقية التي شهدها المغرب بسطات سنة 2025 تؤكد:
استمرار وجود خلايا متأثرة بالفكر الجهادي؛
قدرة التنظيمات الإرهابية على التجنيد؛
حضور الإيديولوجيا المتطرفة في بعض الأوساط.
وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
المقاربة الأمنية وحدها غير كافية؛
لا بد من تفكيك البيئة الإيديولوجية الحاضنة للتطرف؛
لا بد من محاصرة التنظيمات التي تنتج خطاب الكراهية والتكفير ولو كانت تشتغل في غطاء سياسي أو دعوي.
إن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في الخلايا المسلحة، بل في:
الجمعيات المتطرفة؛
التنظيمات الشبه علنية؛
الأحزاب التي تمزج بين الدعوي والسياسي؛
الخطاب الانتخابي المحمّل بالرموز الدينية.
توظيف الدين في الانتخابات تقويض مباشر للديمقراطية
الديمقراطية تقوم على:
حرية الاختيار؛
المساواة بين المواطنين؛
تنافس البرامج لا العقائد؛
سيادة الإرادة الشعبية الحرة.
في حين أن توظيف الدين في الانتخابات يؤدي إلى:
تكفير الخصوم السياسيين ضمنياً أو صراحة؛
تخويف الناخبين بعذاب الآخرة؛
المتاجرة بالمقدس؛
قلب التنافس من مجال مدني إلى مجال عقدي.
وهذا يشكل:
إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص؛
اعتداءً على حرية الضمير؛
تشويهاً للإرادة الانتخابية؛
توظيفاً غير مشروع للرمزية الدينية.
وقد أثبتت التجارب المقارنة في عدة دول أن:
الإسلام السياسي يستخدم الانتخابات كأداة للوصول إلى السلطة؛
ثم يعمل على تقييد الحريات وفرض رؤيته الأحادية؛
ويستعمل المؤسسات الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها.
الإسلام السياسي وخطره على حقوق المرأة والحريات الفردية
يمثل مشروع الإسلام السياسي تهديداً مباشراً لورش إصلاح:
مدونة الأسرة؛
القانون الجنائي؛
تكريس المساواة؛
حرية الضمير؛
الحقوق الفردية.
ذلك أن هذا التيار:
يعارض المساواة الكاملة بين الجنسين؛
يرفض حرية المعتقد؛
يعتبر الحقوق الكونية “غربية”؛
يوظف فهماً متزمتاً للنص الديني لتبرير التمييز.
وقد شكلت حملات التحريض ضد:
المدافعات عن الحقوق الفردية؛
الجمعيات النسائية؛
النشطاء الحقوقيين
دليلاً واضحاً على أن خطاب الكراهية ليس طارئاً، بل هو جزء من البنية الفكرية لهذا التيار.
ومن هنا فإن حماية الديمقراطية لا تنفصل عن:
حماية حقوق المرأة؛
حماية الحريات الفردية؛
تحصين حرية الضمير؛
تحييد الدين عن الصراعات السياسية.
المرجعية الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان
ينص الدستور المغربي على:
سمو المواثيق الدولية؛
حياد الدولة في الشأن الديني السياسي؛
ضمان حرية الفكر والضمير؛
منع التحريض على الكراهية؛
المساواة بين المواطنات والمواطنين.
كما تنص المواثيق الدولية، خاصة:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز؛
قرارات الأمم المتحدة حول التطرف العنيف؛
على:
منع استغلال الدين للتحريض؛
تجريم خطاب الكراهية؛
حماية العملية الديمقراطية من التوظيف العقائدي؛
حق الدولة في تقييد بعض أشكال التعبير عندما تهدد الأمن العام.
وبناء عليه، فإن إلزام الأحزاب بميثاق يمنع استغلال الدين لا يشكل مساساً بحرية التعبير، بل:
يدخل في إطار حماية النظام العام الديمقراطي؛
ويستجيب للالتزامات الدولية للمغرب؛
ويعزز مصداقية التجربة الديمقراطية.
ملامح الميثاق المقترح لإلزام الإسلام السياسي
تقترح الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب اعتماد ميثاق قانوني ملزم، يتضمن على الخصوص:
منع صريح لاستعمال الآيات والأحاديث والشعارات الدينية في الحملات الانتخابية.
منع استغلال المساجد والزوايا ودور العبادة للدعاية الحزبية.
تجريم خطاب التكفير والتخوين الديني في المنافسة السياسية.
منع الجمع بين المسؤوليات الدعوية والسياسية خلال فترة الانتخابات.
إحداث آلية مستقلة لرصد الخطاب الديني الانتخابي.
ترتيب جزاءات واضحة:
إنذار رسمي؛
غرامات مالية؛
إلغاء نتائج الدائرة؛
المنع من الترشح في الاستحقاق الموالي.
ضرورة المنع من المشاركة الانتخابية في حالة الإخلال الجسيم
إن الديمقراطية لا تعني التساهل مع من يستعملها لهدمها من الداخل. ولذلك فإن:
أي حزب يثبت توظيفه للدين؛
أو تحريضه على الكراهية؛
أو تهديده للسلم الاجتماعي
يجب أن يُمنع من المشاركة الانتخابية حماية للنظام العام الديمقراطي.
وهذا الإجراء:
معمول به في عدة دول ديمقراطية؛
لا يتعارض مع الحريات؛
يندرج في منطق الديمقراطية الدفاعية التي تحمي نفسها من أعدائها.
خاتمة عامة
إن المغرب اليوم أمام لحظة مفصلية في تاريخه السياسي، حيث يتقاطع:
ورش الإصلاح الدستوري والتشريعي؛
الخطر الإرهابي المتجدد؛
صعود خطاب الكراهية؛
واستمرار محاولات توظيف الدين انتخابياً.
وترى الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب أن:
تحصين المسار الديمقراطي يمر حتماً عبر تحييد الدين؛
مواجهة الإسلام السياسي ليست مواجهة عقائد، بل مواجهة مشروع توظيفي للدين في السياسة؛
الديمقراطية لا يمكن أن تتعايش مع التكفير والتحريض والكراهية.
ومن هنا، فإننا نؤكد على:
ضرورة إلزام أحزاب الإسلام السياسي بميثاق قانوني مكتوب؛
ضرورة ترتيب جزاءات صارمة في حالة مخالفة هذا الميثاق؛
ضرورة حماية حقوق المرأة والحريات الفردية من الابتزاز الانتخابي الديني؛
ضرورة ربط الأمن بالإصلاح الفكري والقانوني.
فلا ديمقراطية مع خطاب الكراهية، ولا انتخابات نزيهة مع توظيف المقدس، ولا استقرار دون تحصين الأيديولوجيا من التطرف.
* مولاي أحمد الدريدي
على مسؤوليتي
سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة
نشرت
منذ أسبوعينفي
ديسمبر 1, 2025بواسطة
سعيد لكحل
إن قرار إيلون ماسك تفعيل خاصية تحديد مواقع الحسابات على منصة X كان بمثابة ضربة قوية للذباب الالكتروني والمتحكمين فيه لمهاجمة المغرب ومؤسساته الدستورية. فقد أسقط هذا القرار القناع عن تجار الفتن وسماسرة حقوق الإنسان ومدّعي النضال من أجل الديمقراطية الذين انتشروا في مواقع التواصل الاجتماعي كالفطر مباشرة بعد ظهور حركة جيل Z في مدغشقر والنيبال، في سبتمبر 2025، والتي انتهت بسيطرة الجيش على الحكم.
تلك الأحداث أوعزت للعملاء والخونة بتكثيف جهودهم الخبيثة في استقطاب الشباب والتغرير بهم عبر رفع شعارات مغرية ومطالب اجتماعية من أجل توفير وتجويد الخدمات الصحية والتعليمية؛ وهي المطالب التي لا يختلف حولها المغاربة من مختلف الفئات. طبعا لم يكن غرض هؤلاء السماسرة ومنتحلي النضال الحقوقي والسياسي هو الصحة والتعليم أو محاربة الفساد، بل غرضهم المباشر والرئيسي هو تصفية حسابهم من النظام الملكي الذي جعل من المغرب قوة إقليمية لها وزنها السياسي والاقتصادي والأمني والعسكري والسياحي إفريقيا ودوليا.
من هنا جاء توزيع أدوار الخيانة والعمالة بين هؤلاء السماسرة، أذناب قوى إقليمية ودولية ظلت تبتز المغرب لعقود، خصوصا منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية التي جعلوا منها قضية يلوون بها ذراع المغرب لينهبوا ثرواته ويكبحوا جهوده التنموية. فمنهم من تخصص في استهداف جلالة الملك بكل الأساليب الخسيسة، ومنهم من جعل من مهاجمة الأجهزة الأمنية خبزه اليومي، فيما اختص الآخرون بتسفيه المؤسسات المنتخبة لضرب مصداقيتها. هكذا تقاطعت أهداف خونة الداخل مع أهداف خونة الخارج وعملاء أعداء الوطن ووحدته الترابية فجعلوا من حركة زد حصان طروادة عساهم يخترقوا حصون الدولة وركائزها الأمنية والقضائية والاقتصادية والتجارية. كانت خطتهم متكاملة ومعدّة مسبقا سرعان ما انفضحت لما تمت مهاجمة مقر الدرك الملكي بالقليعة وإحراق الأبناء والصيدليات ونهب المحال التجارية والأسواق الممتازة وتخريب الممتلكات الخاصة والعامة، ثم أشاعوا رسو البواخر الإسرائيلية محملة بالأسلحة بالموانئ المغربية بطنجة والدار البيضاء، ليحرضوا الشباب المغرر بهم على محاصرتها وضرب العصب التجاري والاقتصادي الحيوي للمغرب.
لم يكتف الخونة والعملاء باستهداف القطاعات الإستراتيجية والحيوية، بل امتد مخططهم الخبيث إلى تجييش المغرر بهم لرفع شعارات تطالب بوقف بناء الملاعب الرياضية والتحريض على مقاطعة مباريات الفريق الوطني لكرة القدم والمطالبة بإلغاء تنظيم كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم 2030. فأثبتوا عمالتهم لنظام الكابرانات وخدمة أجندته العدائية للمغرب. الأمر الذي جعل الشباب المغربي الذي التحق بالاحتجاجات ورفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد يدرك الأهداف الانقلابية للمتحكمين في حركة زد والموجهين لها، ليقرر الانسحاب ومقاطعة دعواتها للاحتجاج.
الغربان تقود إلى الجيَف.
ليس صدفة أن تكشف بيانات صادرة عن شركة NETSCOUT SYSTEMS” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني حول التهديدات الإلكترونية، أن المغرب من أكثر الدول عرضة لهذه التهديدات على المستوى القاري خلال النصف الأول من عام 2025. نفس الأمر أكده إعلان شركة Kaspersky عن تسجيل ما يقارب 21 مليون محاولة هجوم إلكتروني بالمغرب خلال النصف الأول من عام 2025.
إذن هناك مخططات عدائية من أطراف متعددة تستهدف أمن المغرب واستقراره بأساليب خسيسة، على رأسها النظام الجزائري. وهذا ما أكدته نتائج التحقيقات التقنية أن الهجمات تحمل أنماطاً وبصمات سبق تسجيلها في عمليات إلكترونية صادرة من جهات مرتبطة بالجزائر. كما تم رصد استخدام بنية تحتية رقمية متطورة، تشمل خوادم وسيطة وعناوين بروتوكول إنترنت، توحي بوجود دعم منظم وموجّه من الخارج. وقد تأكدت هذه الحقيقة مباشرة بعد قرار إيلون ماسك حيث تبين أن المصدرين الرئيسيين للهجمات الإلكترونية والتحريض على الفتن والعنف هما الجزائر وقطر وكندا، عبر استغلال القضايا الاجتماعية في وسائل التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى حملات ممنهجة من الأخبار الزائفة والشائعات لإثارة القلاقل لضرب استقرار المغرب.
ما أن فعّل موقع X خاصية تحديد المواقع حتى اختفت عشرات الآلاف من الصفحات المزيفة التي تقمص أصحابها الجنسية المغربية للتحريض ضد المؤسسات ونشر الشائعات للتأثير على الرأي العام الوطني. ومنذ الوهلة الأولى التي رفض فيها المتحكمون في حركة جيل Z الكشف عن هوياتهم تأكدت عمالتهم للخارج وخيانتهم للوطن وخدمتهم لأجندات معادية للمغرب ولوحدته الترابية. ذلك أن الهويات المجهولة لن تقود إلا إلى المجهول؛ وكما يقول المثل العربي “من يتخذ الغراب دليله قاده إلى الجيف”. والمغاربة، بمختلف شرائحهم، أثبتوا لأعداء وطنهم أن حملات التضليل والتحريض ونشر الأخبار الزائفة وترويج الإشاعات المغرضة لن تخدعهم كما خدعت شعوبا عربية هي اليوم تدفع ثمن اتخاذها من الغربان دليلا لها.

بطولة إسبانيا: ثنائية رافينيا تعزز صدارة برشلونة إلى سبع نقاط

إسرائيل تعلن قتل قيادي عسكري في حماس بضربة في غزة

أمم إفريقيا: محرز وزيدان يتصدران تشكيلة المنتخب الجزائري

الصحافة الإسبانية تشيد بأوناحي، صانع ألعاب جيرونا

حصيلة الفيضانات في إندونيسيا تتخطى الألف قتيل

توقعات أحوال الطقس لليوم السبت

كأس العرب: .المنتخب الوطني المغربي يواجه نظيره الإماراتي

كأس العرب: الامارات تجرد الجزائر من اللقب

المغرب الرقمي 2030..1,3 مليار درهم لتطوير منظومة المقاولات الناشئة

لفتيت يعقد اجتماعا مع رؤساء الجهات حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة

المنتخب الوطني للقاعة سادس عالميًا والنسوي يتصدر إفريقيا

السلطات الإيرانية تعتقل نرجس الحائزة على جائزة نوبل للسلام

Attijari Payment تستحوذ على جزء من عقود المركز المغربي للنقديات

كأس أمم افريقيا: المنتخب المصري يعلن قائمة لاعبيه

البيان الختامي لاجتماع النيابات العامة أطراف الاتفاق الرباعي لمكافحة الإرهاب

النادي السينمائي نور الدين الصايل يستضيف المخرج محمد الشريف الطريبق بأكادير

كأس العرب: الأردن يصطدم بالعراق والإمارات تتحدى الجزائر

11 وفاة في غزة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة

توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة

كأس العرب..السعودية تتأهل لنصف النهائي بالفوز على فلسطين (2-1)

مدينة الصويرة تحتفي بأحد أبنائها البررة..محمد عبيد

إطلاق الدورة العاشرة للمنتدى الدولي للإعلام بواشنطن

سعيد الكحل: سقوط الأقنعة عن تجار الفتنة

كاس العرب 2025: المنتخب الجزائري حامل اللقب يكتفي بالتعادل مع السودان صفر-صفر

نحو إلزام الأحزاب الإسلامية بميثاق قانوني لوقف توظيف الدين وخطاب الكراهية

اختراق أمني يستهدف بيانات مستخدمي ChatGPT

أمريكا تقلص مدة انتظار التأشيرة بالمغرب إلى شهرين استعدادا لمونديال 2026

سعيد الكحل: الفقيه الريسوني يعود إلى عادته القديمة

سعيد الناصري يطرح فيلمه الجديد “الشلاهبية” على يوتيوب

هيئات نقابية صحافية تجدد رفضها القاطع لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

هذه هي الشروط الجديدة لدعم ترشح الشباب في الانتخابات

قرعة مونديال 2026: المغرب يقع في مجموعة البرازيل

وزير الداخلية يذكر باستمرار تسجيل الناخبين

محاكمة جديدة لسعد لمجرد بتهمة الاغتصاب في فرنسا

محكمة فرنسية تقرر تأجيل محاكمة سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب

مجلس التعاون الخليجي يجدد التأكيد على مغربية الصحراء ويرحب بقرار مجلس الأمن 2797

غوغل تكشف عن تحديث يتيح للشركات الاطلاع على رسائل الموظفين النصية!

المنتخب الوطني الرديف يستعد للقاء جزر القمر في كأس العرب

مراكش.. توقيف متورطين في سرقة سائحة أجنبية

الجديدة: 90 سنة سجنا للمتابعين الستة في قضية اغتصاب قاصر

مدينة الصويرة تحتفي بأحد أبنائها البررة..محمد عبيد

🔴 مباشر | الخطاب الملكي السامي

الدار البيضاء.. انطلاق المرحلة الرابعة من سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء

الخبير جمال العلمي يكشف أسرار ” صومعة المكانة” La Tour de l’Horloge

“الدوري الأول للراحلة حليمة مرجان”..الرياضة في خدمة العمل الخيري

الرباط تكرّم الراحل يونس رودياس أحد رموز كرة السلة بنادي الفتح الرياضي

الوداد الرياضي يحتفل بذكراه الـ88.. ليلة وفاء وتكريم لأساطير الأحمر

المغرب يدخل عصر العلاج الثوري لسرطان البروستاتا بتقنية HIFU

في حفل تأبيني مؤثر.. سبور بلازا يكرم روح الراحل كمال لشتاف

نادي “النور اولاد صالح” ينظم الدوري السنوي للكرة الحديدية

تفاصيل مؤامرة الجنرال أوفقير على رفاقه في الجيش وعلى الحسن الثاني

محمد لومة يحكي عن أخطر جرائم أوفقير في حق الوطن والشعب

للمرة الثانية الرباط تحتضن التجمع التدريبي الافريقي BAL في كرة السلة

هكذا اقتطعت الجزائر أجزاء من التراب المغربي و التونسي بدعم من فرنسا ( فيديو)

بالفيديو..تفاصيل محاولة اغتيال الحسن الثاني سنة 1972

1981: مقترح “الاستفتاء” حول الصحراء..عندما قال عبد الرحيم بوعبيد “لا” للحسن الثاني

محمد لومة يكشف مراحل الصراع بين الحسن الثاني و عبد الرحيم بوعبيد (الجزء الأول)

تفاصيل تحكى لأول مرة عن اغتيال الشهيد عمر بن حلون (الحلقة الثانية)

و شهد شاهد من أهلها..حقائق تكشف لأول مرة عن اغتيال الشهيد عمر بن جلون

حورية أجدور..صوت مجدد صاعد في سماء الأغنية الأمازيغية “فيديو “
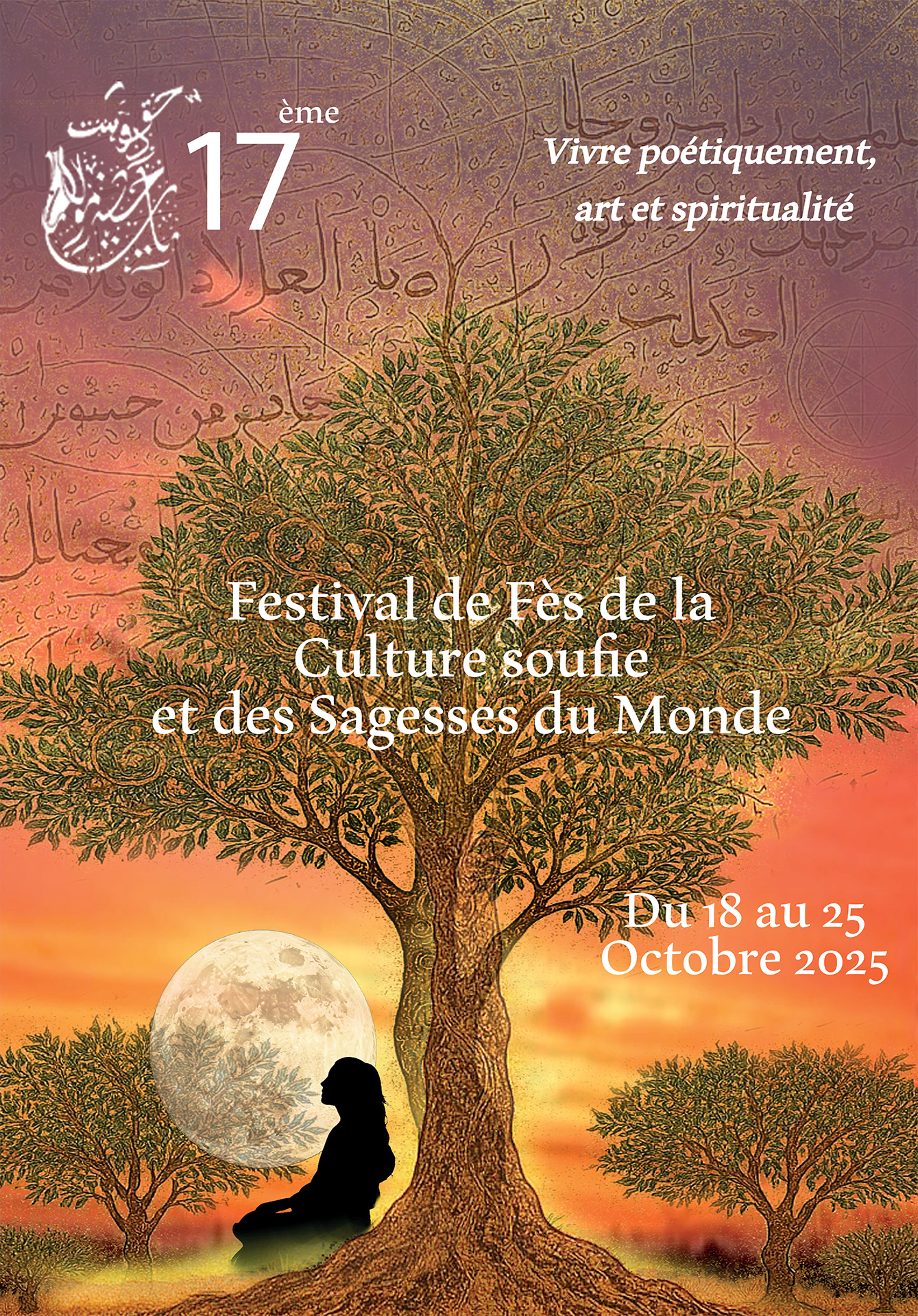
الاكثر مشاهدة
-

 على مسؤوليتي منذ 6 أيام
على مسؤوليتي منذ 6 أيامسعيد الكحل: الفقيه الريسوني يعود إلى عادته القديمة
-

 واجهة منذ 4 أيام
واجهة منذ 4 أيامالمحامي الادريسي يقرر سلك المساطر القانونية ضد أعضاء لجنة أخلاقيات الصحافة
-

 اقتصاد منذ 4 أيام
اقتصاد منذ 4 أيامالتجاري وفا بنك يتجاوز عتبة 10 مليارات درهم خلال 2025
-

 رياضة منذ 5 أيام
رياضة منذ 5 أيامهؤلاء هم أفضل هدافي كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ
-

 منوعات منذ 4 أيام
منوعات منذ 4 أيامادراج القفطان المغربي ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادي لليونسكو
-

 منوعات منذ 3 أيام
منوعات منذ 3 أيامالدار البيضاء: معرض “خمسون” يحتفي بأعمال 50 فنانا
-

 رياضة منذ 6 أيام
رياضة منذ 6 أيامخسارة صادمة لريال مدريد على أرضه من سيلتا فيغو
-

 رياضة منذ يومين
رياضة منذ يومينكأس العرب: الأردن يصطدم بالعراق والإمارات تتحدى الجزائر